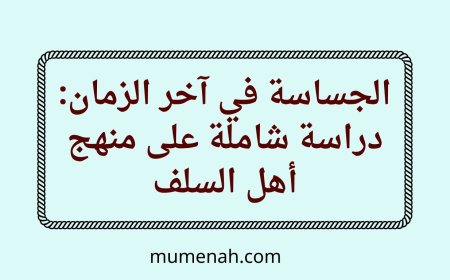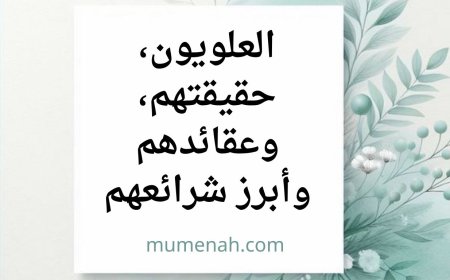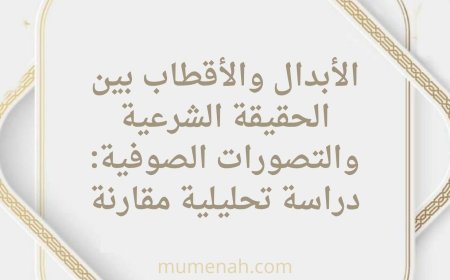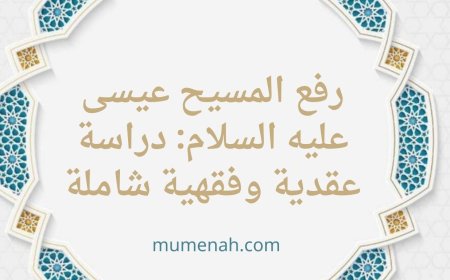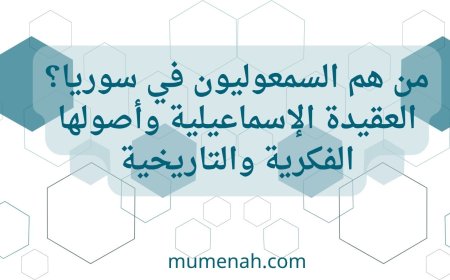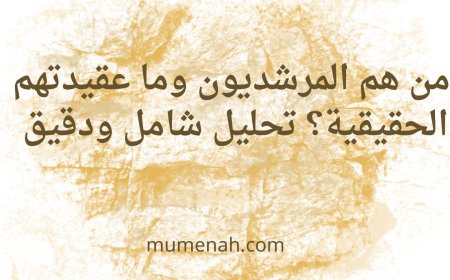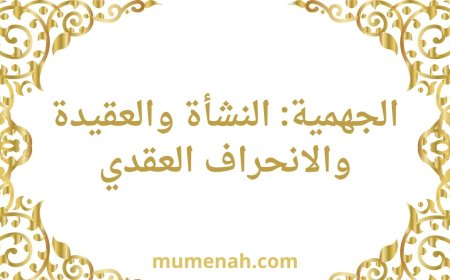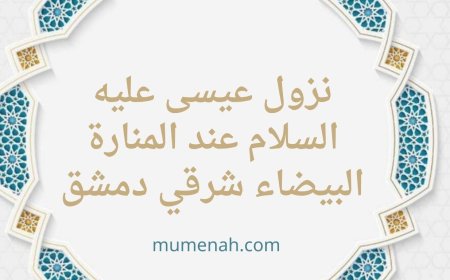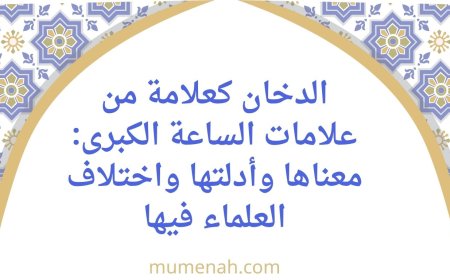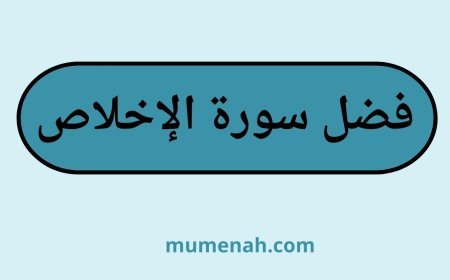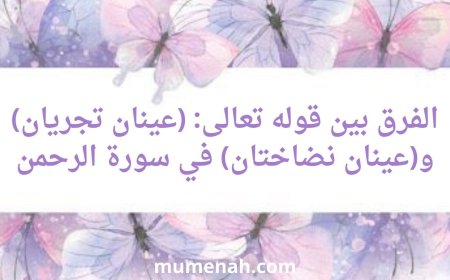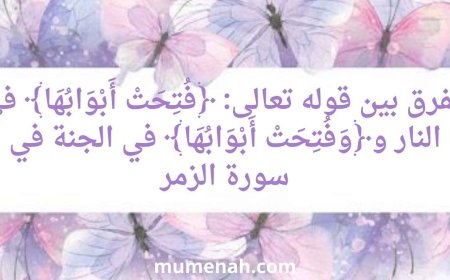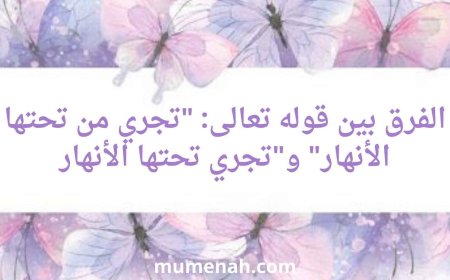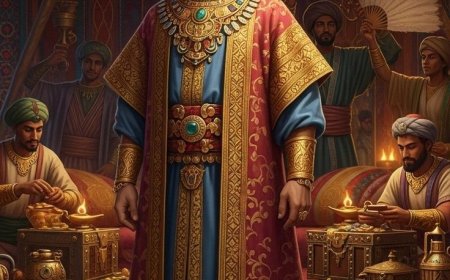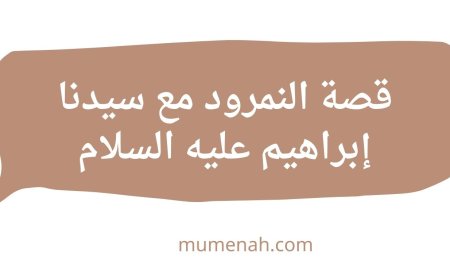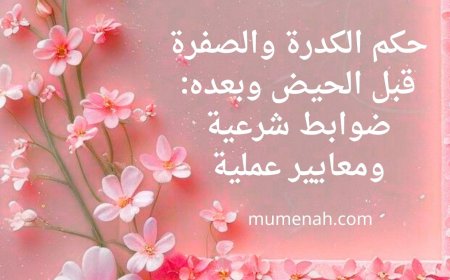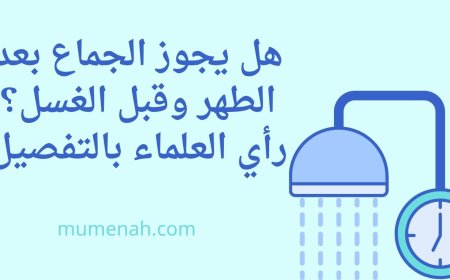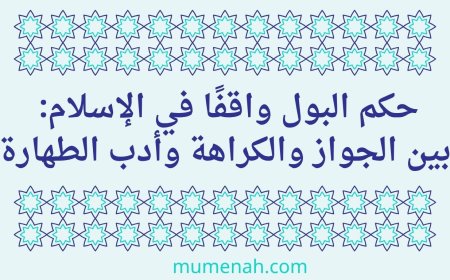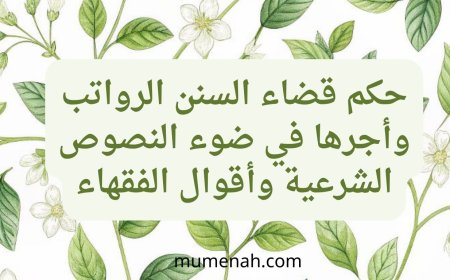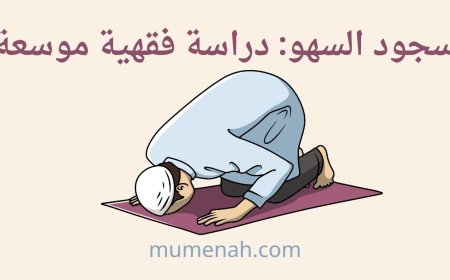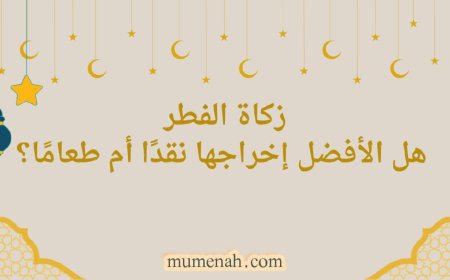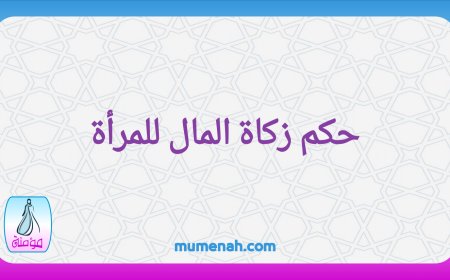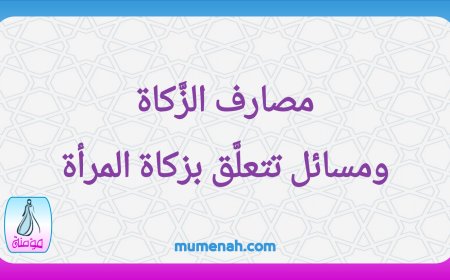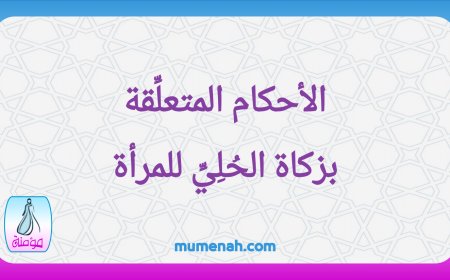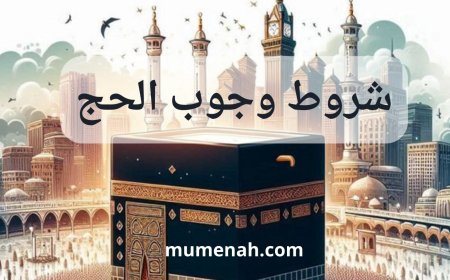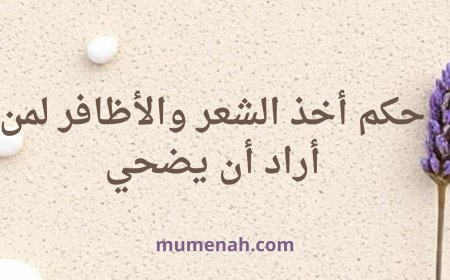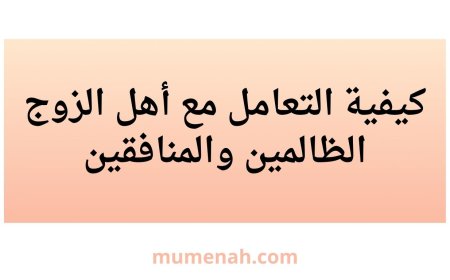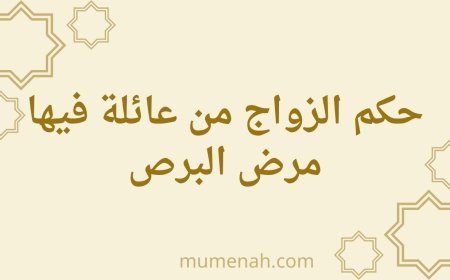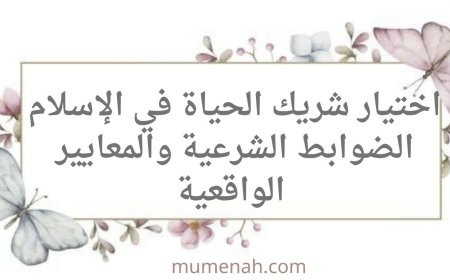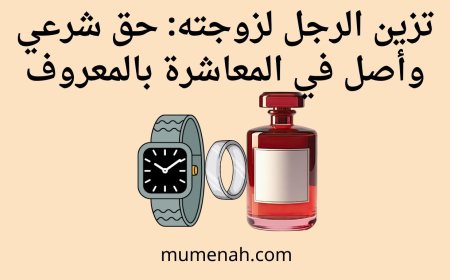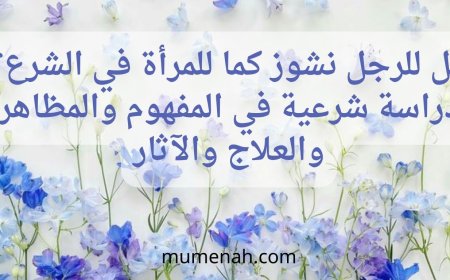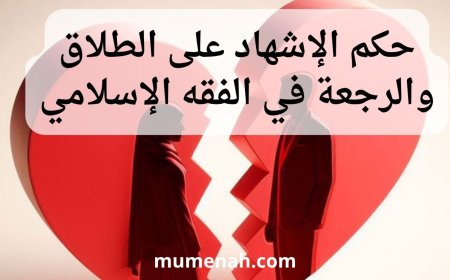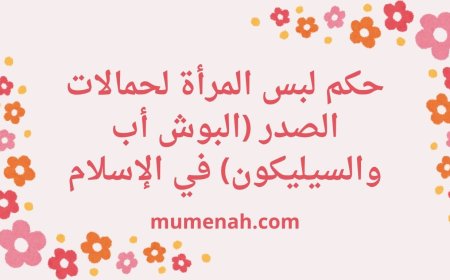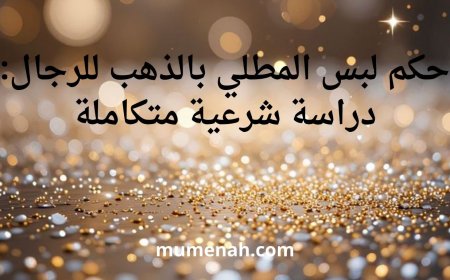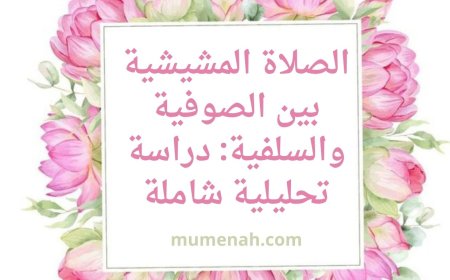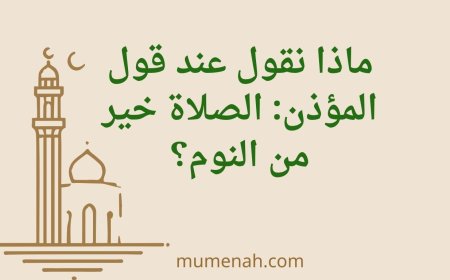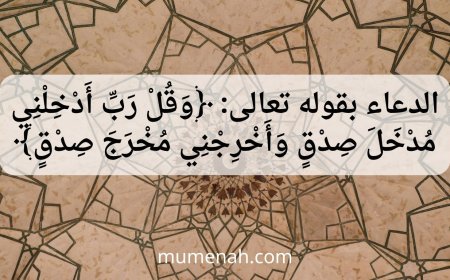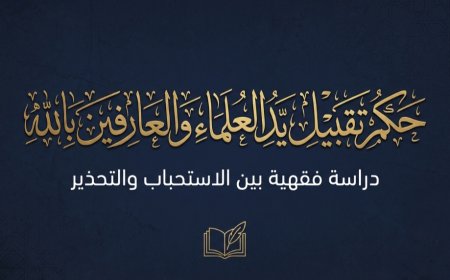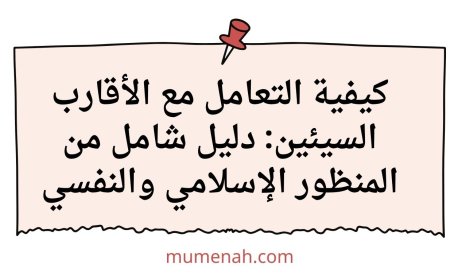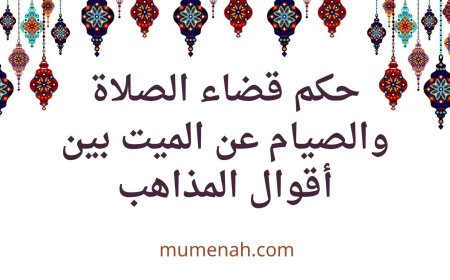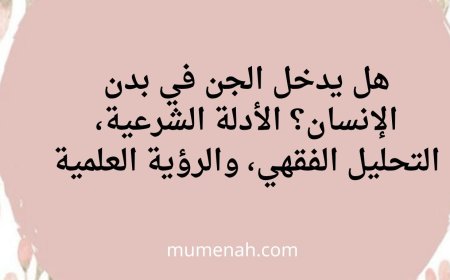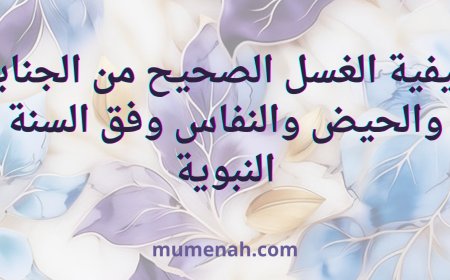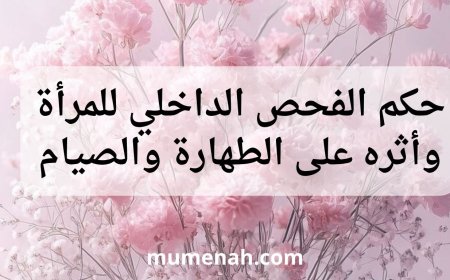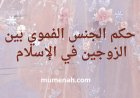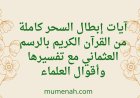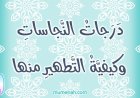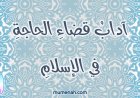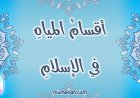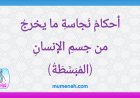النوم ونقض الوضوء: دليل فقهي وعلمي بين المذاهب الأربعة
«مقال تفصيلي في فقه النوم وأثره على نقض الوضوء بين المذاهب الأربعة، مدعوم بمعلومات علمية عن مراحل النوم وآليات زوال الإحساس، وتحليلٌ فقهي دقيق للتطبيقات العملية.»
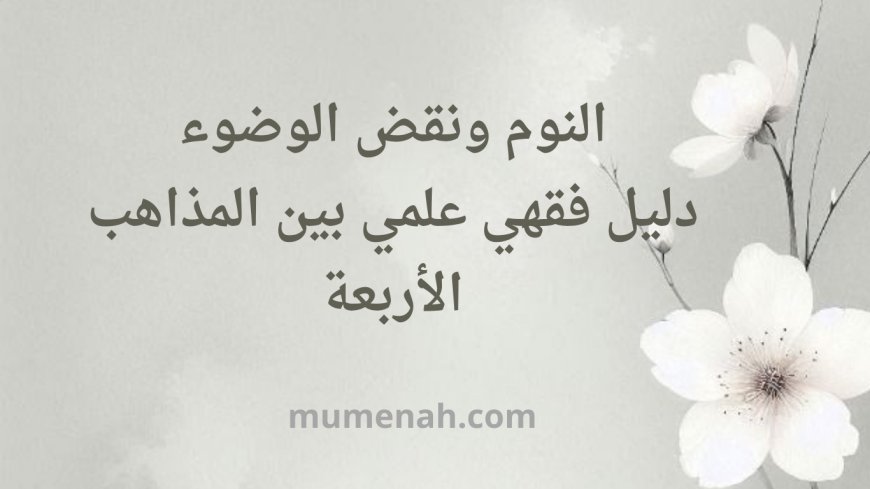
-
تمهيد
يُعدّ الكلام عن أثر النوم على نقض الوضوء من المسائل الفقهية الدقيقة، إذ تجمع جميع المذاهب على أن زوال العقل – مهما كان سببه – يظلّ سببًا محتملاً لنقض الوضوء. وفيما يلي شرح مفصّل للمسألة
-
زوال العقل وأثره في نقض الوضوء
- مفهوم النقض: خروج شيء من السبيلين (ماء أو ريح أو غيرهما) مع غلبة العقل، أو زواله بحيث لا يشعر المصلي بحاله.
- أمثلة على زوال العقل:
- النوم الثقيل والعميق.
- حالات ذهول العقل: الجنون، الإغماء، السكر الشديد.
- قاعدة عامة: “زائل العقل لا يشعر بحاله”، والنوم بالمراحل العميقة يعادل في المنع زوال العقل بإغماء أو جنون.
- مفهوم النقض: خروج شيء من السبيلين (ماء أو ريح أو غيرهما) مع غلبة العقل، أو زواله بحيث لا يشعر المصلي بحاله.
-
الأدلة النبوية على أن النوم مظنة للنقض
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
«العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» (متفق عليه في بعض الروايات). - عن معاوية بن وهب:
«العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء». - الاستدلال: هذان الحديثان لا يثبتان أن النوم بذاته ناقض للوضوء، بل يؤكدان أنّ الظَّنَّ بنقض الوضوء قائمٌ عند النوم؛ لأن احتمال خروج شيء مِن المخرجين أكبر.
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
-
أقوال الفقهاء مفصّلة في نقض الوضوء بسبب النوم
. الرأي الأول (الحنفية والشافعية)
1. نومٌ ناقض للوضوء:
o النوم مضطجعًا أو متكئًا أو منكَبًّا بحيث لا تتمكن المقعدة من الأرض.
o مثال: النوم على الفراش مضطجعًا، أو الاتكاء على الوسادة.
2. نومٌ غير ناقض:
o النوم قاعدًا قائمًا:
§ قعودًا على الأرض أو على ظهر دابة سائرة: لا ينقض الوضوء؛ لأن المقعدة على الأرض ممكنة.
§ إذا استند إلى شيءٍ يسقط بزواله:
§ عند الحنفية: ينقض الوضوء؛ لأن الاسترخاء بلغ منتهاه.
§ عند الشافعية: لا ينقض إذا بقي احتمالُ “الأرض تحت المقعدة”؛ فلا خوف من خروج شيء.
o النوم أثناء القيام أو الركوع أو السجود:
§ عند الحنفية لا ينقض، لأن بعض “الاستمساك” بالبقاء قائمًا موجود، ولو زال لسقط المصلي.
3. الأدلة التفصيلية:
o عن ابن عباس:
«ليس على من نام ساجدًا وضوء، حتى يضطجع؛ فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله».
(رواه أبو داود والبيهقي)o عن أنس بن مالك:
«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودًا ثم يصلون ولا يتوضؤون».o عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
«من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء».o عن ابن عمر:
نام جالسًا ثم قام يصلّي فلا وضوء عليه.o في حديث ابن عباس الراوي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده حتى غطّت عيناه ثم قام يصلّي دون وضوء.
٣.٢. الرأي الثاني (المالكية والحنابلة)
1. نومٌ ثقیل ناقض:
o ولو قصر زمنه، فالثقيل هو الذي لا يشعر فيه صاحبه بأي صوتٍ خارجي أو بسقوط شيءٍ من يده أو بسيلان لعابه.
2. نومٌ خفيف غير ناقض:
o ولو طال زمنه، فهو الذي يبقى فيه الإحساس الجزئي بما حوله.
3. الحنابلة:
o عمومُ النوم المضطجع ناقضٌ، إلا النوم القليل عرفًا في الجالس أو القائم.
o معيارهم: المألوف عرفًا في العادة يُميّز النوم الخفيف من الثقيل.
o في الشكّ: يُرجّح بقاء الطهارة؛ لأن الأصل عدم النقص.
4. الأدلة التفصيلية:
o عن أنس:
«ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون».o عن ابن عباس:
وصفه للنوم في حضرة ميمونة وامساك النبي بأذنه حين يغفو، ثم استكمال صلاة الليل إحدى عشرة ركعة. -
استنتاج فقهي إجمالي بناء على الادلة الفقهية المعتبرة
- الإجماع: النوم المضطجع (بلا إمكانية للمقعدة على الأرض) ناقض للوضوء عند الجمهور.
- القياس: زوال العقل بأي سببٍ (نوم عميق، إغماء، جنون، سكر) ينقض الوضوء بحكم المماثلة.
- الأصول:
1. الأصل بقاء الطهارة ما لم يقترن زوال العقل بخروج شيء.
2. مظنة خروج شيء – مثل نوم العين – تعطي احتمال النقض، وعليه يُستحب الوضوء.
- الإجماع: النوم المضطجع (بلا إمكانية للمقعدة على الأرض) ناقض للوضوء عند الجمهور.
-
النوم وأثره على الدماغ والحسّ علمياً
1. مراحل النوم
o المرحلة الأولى (NREM 1): انتقال من اليقظة إلى النوم الخفيف، يشعر فيه النائم ببطء في حركة العيون واضطراب خفيف في العضلات.
o المرحلة الثانية (NREM 2): نوم خفيف مستقر نسبيًا، يبدأ فيه تراجع ردة الفعل للأصوات الخارجية.
o المرحلة الثالثة (NREM 3 أو النوم العميق): غياب شبه تام للاستجابة للمؤثرات الخارجية، تُسجل موجات دلتا البطيئة في تخطيط الدماغ.
o مرحلة حركة العين السريعة (REM): نشاط دماغي يشبه اليقظة مع أحلام واضحة، غير أن الجسم يدخل في شلل مؤقت للعضلات الإرادية.
2. آليات زوال الإحساس
o كلية الأعصاب الحسية: خلال النوم العميق، تنخفض وظائف اللويحات العصبية في القشرة الحسية بالجملة الشوكي-دماغي، فيقل وصول إشارات الشعور خارجياً.
o الجهاز الشبكي الناشط (Reticular Activating System): يقل نشاطه أثناء النوم العميق، فيتراجع الوعي التام بالمؤثرات.
3. العلاقة بالفقه
o الحديث عن “زوال العقل” يوازي في الطب الحديث بدء ظهور موجات دلتا، أي الحالة التي يصعب فيها انتباه النائم للأصوات والتحفيزات.
4. فوائد النوم العميق
o تنقية الدماغ من البروتينات الضارة (مثل بيتا–أميلويد).
o تعزيز تثبيت الذاكرة وتنظيم الانفعالات.
-
مسائل عملية شائعة
- النوم أثناء الصلاة: في حال اضطجع المصلي حتى غلبه النوم عميقًا، وجب الوضوء ثم استئناف الصلاة.
- النوم قاعدًا جالسًا:
- خفيف عرفًا: لا يوجب الوضوء عند الجميع.
- ثقيل عرفًا: يوجب الوضوء عند المالكية والحنابلة، ولا يوجب عند الحنفية والشافعية إذا بقيت المقعدة ممكنة على الأرض.
- الشكّ في عمق النوم: يرجح بقاء الطهارة، فلا وضوء إلا بيقين النقض.
- النوم في الصلاة الجالسة أو السجود: لا وضوء على من نام جالسًا أو ساجدًا إلا إذا اضطجع فعلاً.
- النوم أثناء الصلاة: في حال اضطجع المصلي حتى غلبه النوم عميقًا، وجب الوضوء ثم استئناف الصلاة.
-
خاتمة
إن مسألة النوم ونقض الوضوء تتقاطع فيها نصوص الشريعة مع حقائق علمية حديثة، فتتضح صورة “زوال العقل” بمعايير طبّية دقيقة تتناغم مع أدلة الشرع. على المسلم أن يتحرى اليقين في طهارته، مستفيدًا من فقه الأصول ومعطيات العلوم العصبية، ليؤدي عباداته براحة بالٍ تامّة.