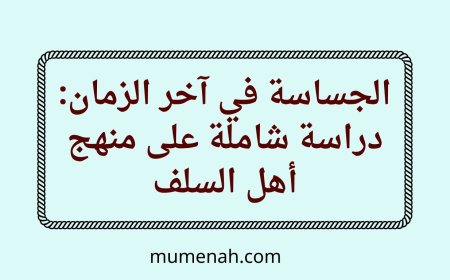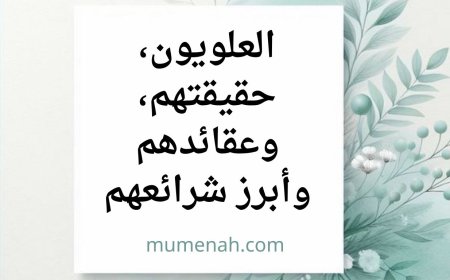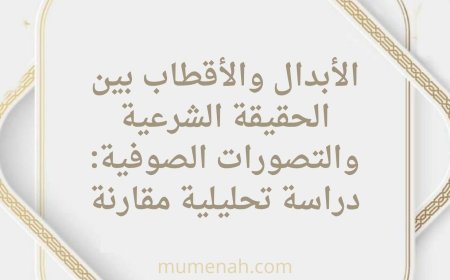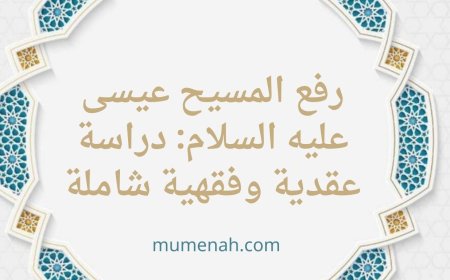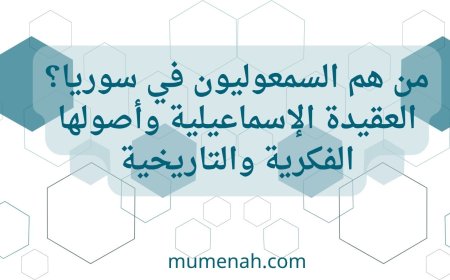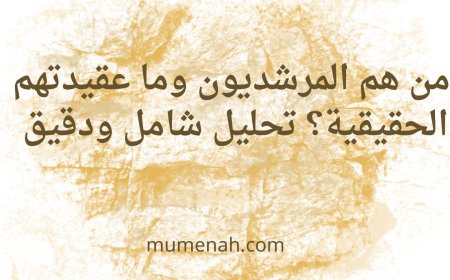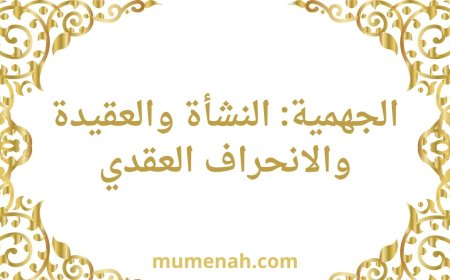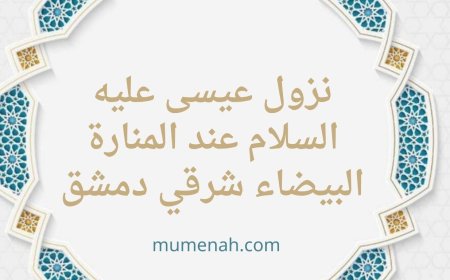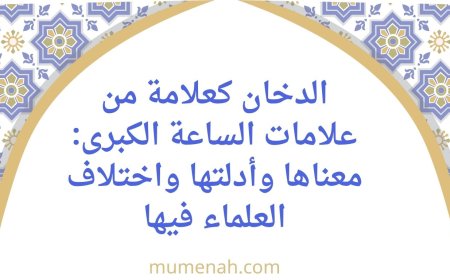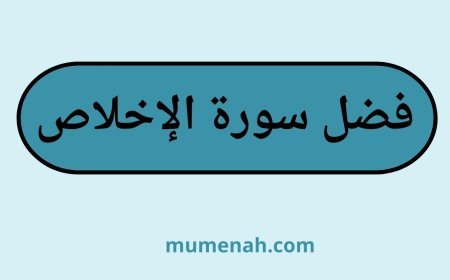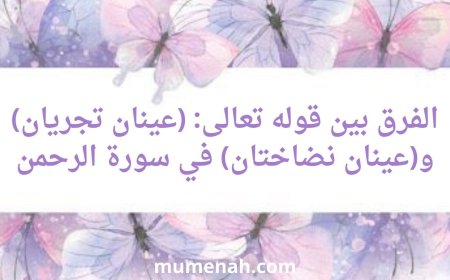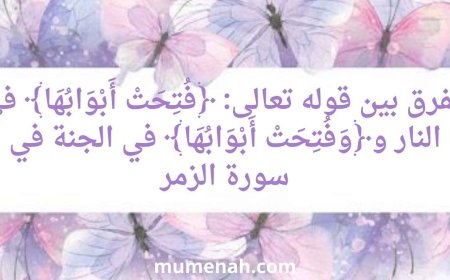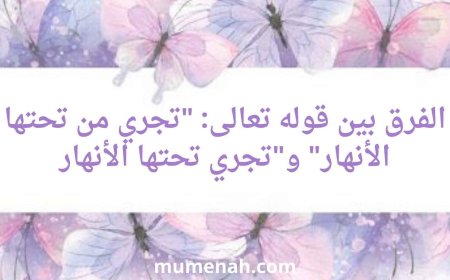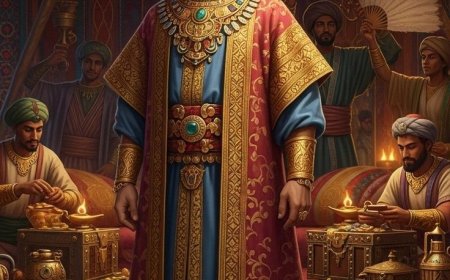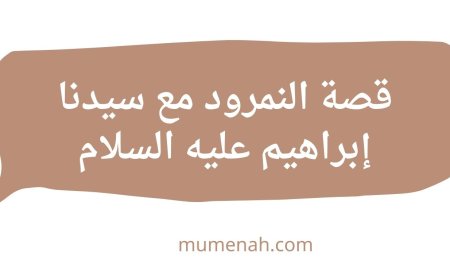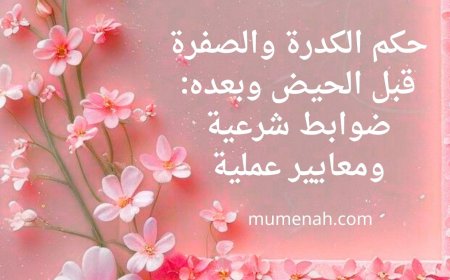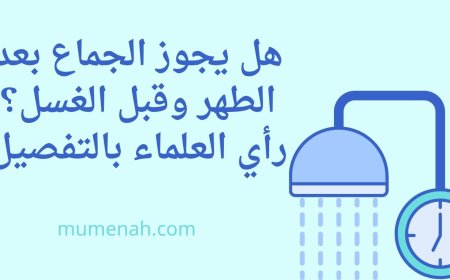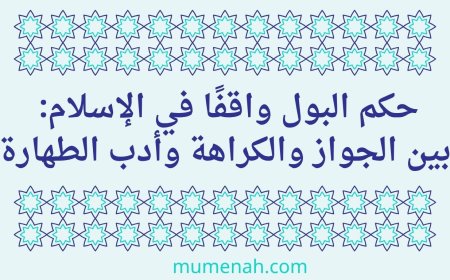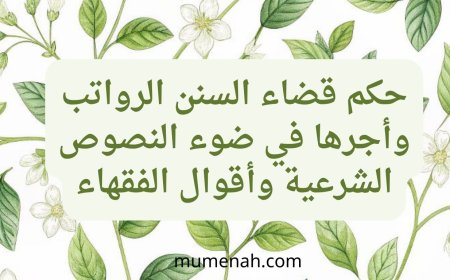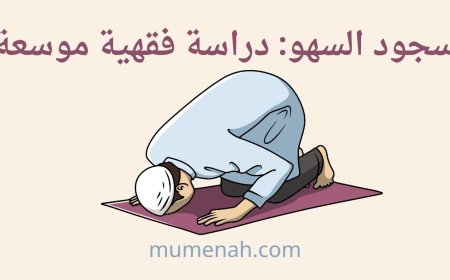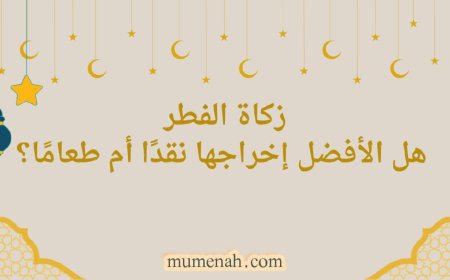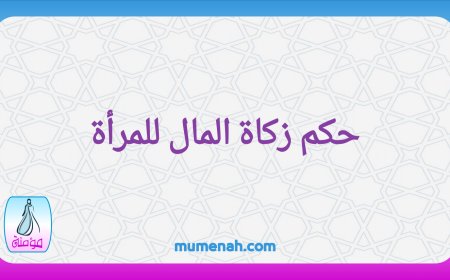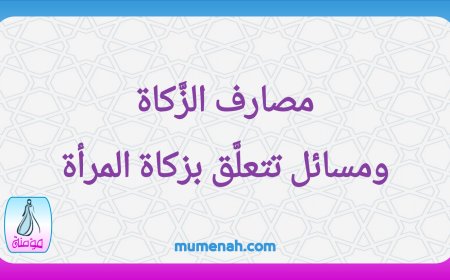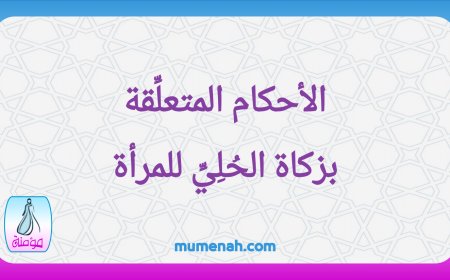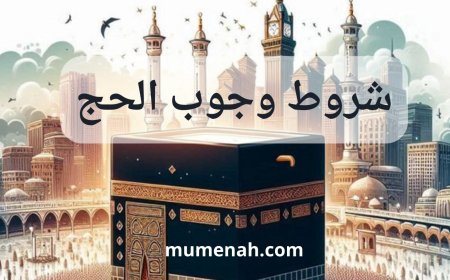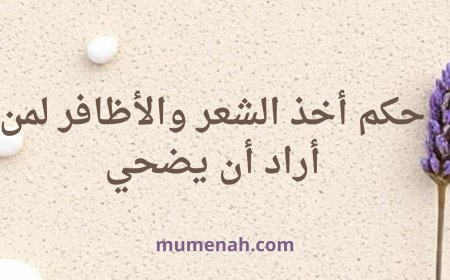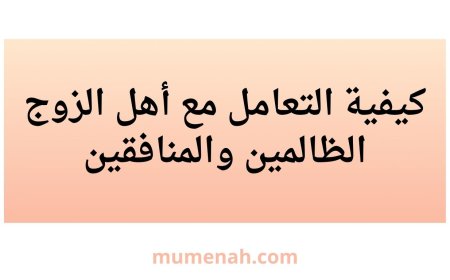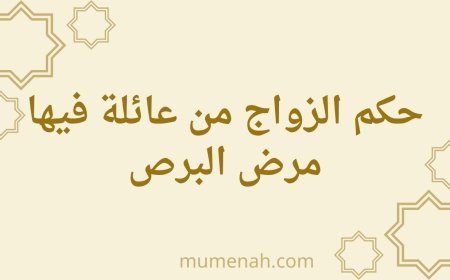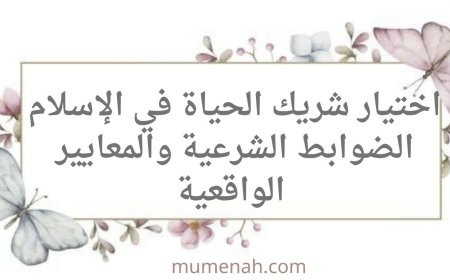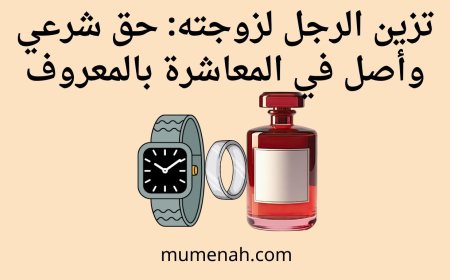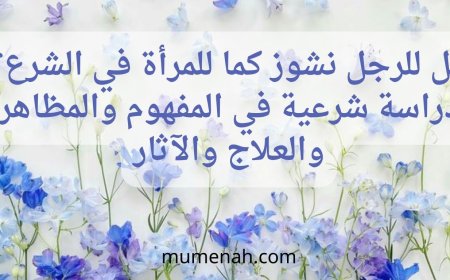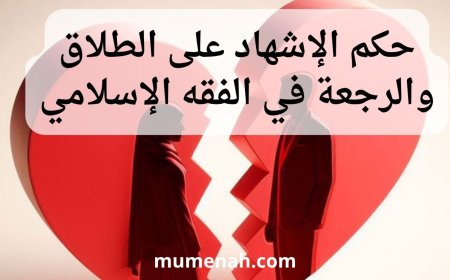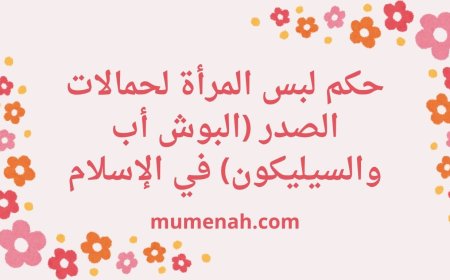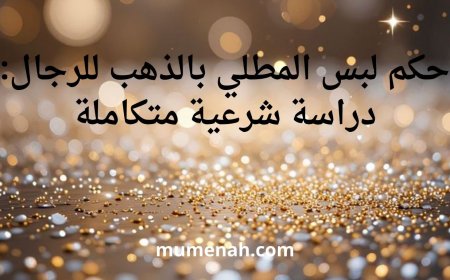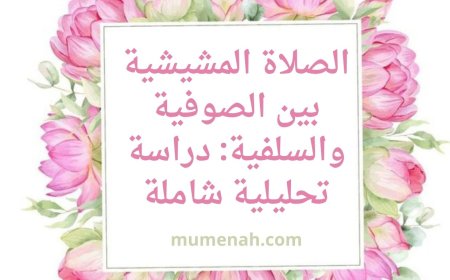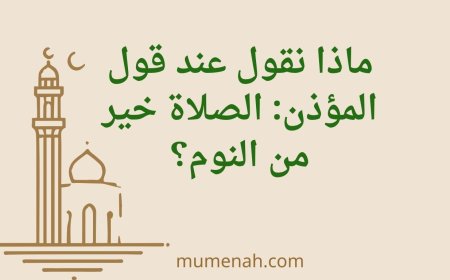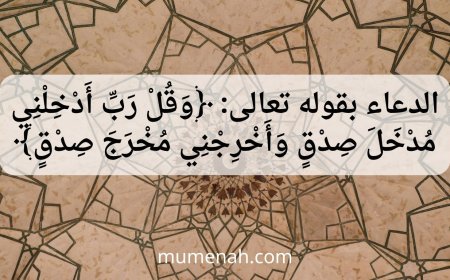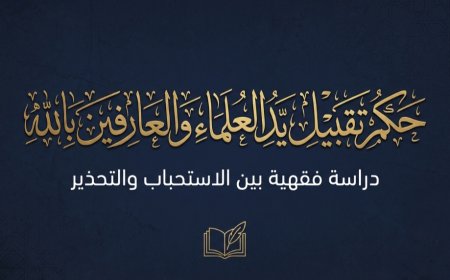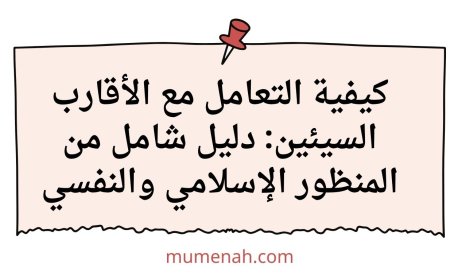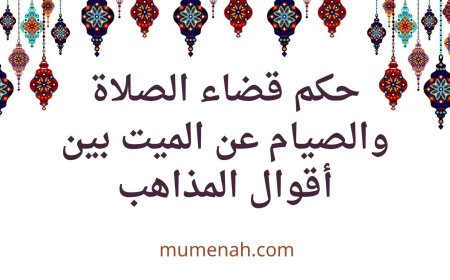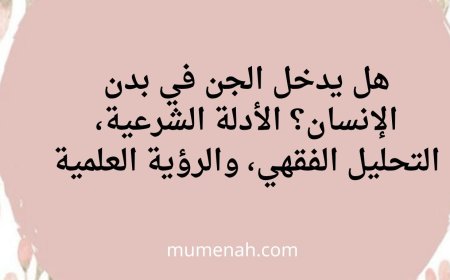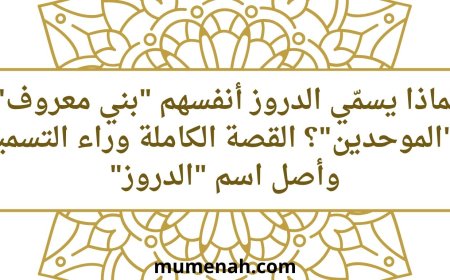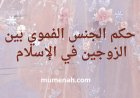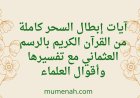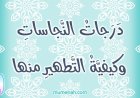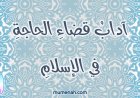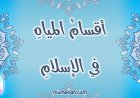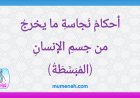الجهمية: النشأة والعقيدة والانحراف العقدي
تعرف على فرقة الجهمية، من هو الجهم بن صفوان، وما هي معتقداتهم في الصفات الإلهية وخلق القرآن والإيمان والقدر، مع أقوال العلماء في بيان ضلالهم وموقف السلف الصالح منهم، في دراسة عقدية موثوقة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة.
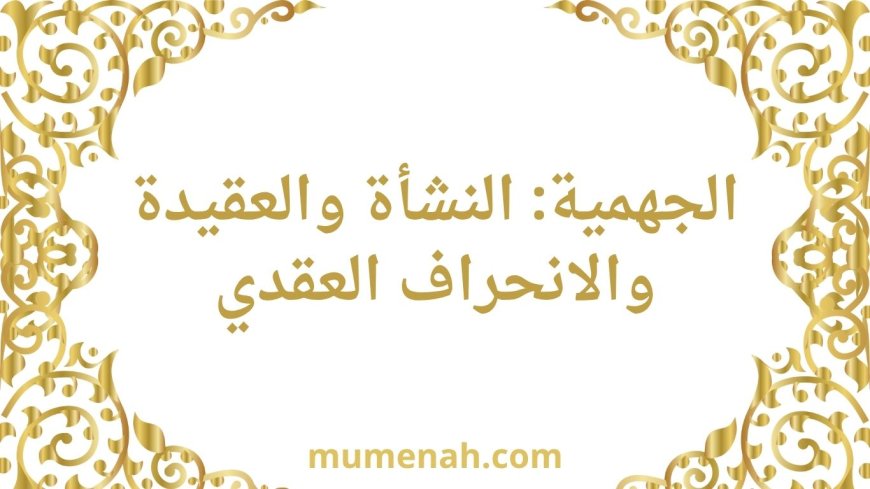
-
النشأة التاريخية
- المؤسس: الجهم بن صفوان الترمذي (قُتل سنة 128هـ)، وتُنسب الفرقة إليه.
- المنشأ: ظهرت في أواخر الدولة الأموية بخراسان، وتحديدًا في ترمذ.
- الأصل الفكري: تلقى الجهم فكره من الجعد بن درهم، الذي قُتل بسبب زندقته على يد خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى، لما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليمًا.
- الامتداد: انتشرت أفكار الجهمية بعد مقتله على يد بعض تلاميذه، وأثرت لاحقًا في فرق أخرى كالمعتزلة.
- المؤسس: الجهم بن صفوان الترمذي (قُتل سنة 128هـ)، وتُنسب الفرقة إليه.
-
أبرز معتقدات الجهمية
. نفي الصفات الإلهية
- قالوا: لا يجوز وصف الله بأي صفة يوصف بها خلقه، ونفوا الصفات كلها بزعم التنزيه.
- جعلوا الصفة الوحيدة لله هي الوجود المطلق، لا موصوف له بسمع أو بصر أو كلام أو علم أو قدرة.
- قالوا إن أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على صفات، فـ"الكريم" عندهم ليس بمعنى صاحب الكرم، بل هو اسم لذات مجردة، والكرم مخلوق منفصل.
- لذا عدّهم العلماء من المعطلة، الذين عطلوا الله عن صفاته.
2. القول بخلق القرآن
- قالوا إن القرآن مخلوق، لا كلام الله حقيقة، لأنهم نفوا صفة الكلام عن الله تعالى.
- خالفوا بذلك نصوص الوحي وإجماع السلف، قال الله تعالى:
{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164].
3. الإيمان عند الجهمية
- جعلوا الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين.
- بناءً على هذا الأصل، قالوا إن فرعون وإبليس مؤمنان لأنهما عرفا الله.
- قال الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والنحل:
"كان جهم يقول إن الإيمان عقد بالقلب، وإن عبد الصليب والأوثان بلسانه ولم ينكر بقلبه فهو مؤمن".
- وهذا القول من أشد أنواع الإرجاء، لذا عُدّوا من غلاة المرجئة.
4. في القدر
- الجهمية جبرية خالصة، يقولون إن العبد لا يملك فعلًا ولا اختيارًا، بل هو كريشة في مهب الريح.
- قالوا: "لا قدرة للعبد على الفعل، بل يُجبر على عمله".
- وهذا يناقض قوله تعالى:
{لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ} [التكوير: 28].
5. في الغيبيات والمعاد
- أنكروا ما لا تدركه العقول من الغيب كالرؤية والملائكة والعرش.
- قالوا: الله ليس على العرش بل في كل مكان.
- أنكروا دوام الجنة والنار، وقالوا إنهما تفنيان، لأن بقاءهما عندهم ظلم.
- وهذه أقوال منكرة خالفت نصوص الكتاب والسنة، قال تعالى:
{خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: 57].
- قالوا: لا يجوز وصف الله بأي صفة يوصف بها خلقه، ونفوا الصفات كلها بزعم التنزيه.
-
أبرز أعلامهم
1. الجعد بن درهم — المؤسس الفكري الأول.
2. الجهم بن صفوان — رأس الفرقة والمنسوب إليها الاسم.
3. بشر بن غياث المريسي (ت. 218هـ) — من غلاتهم المشهورين، وكان من المتكلمين الذين قالوا بخلق القرآن، فذمه العلماء وكفره كثير منهم.
-
موقف العلماء من الجهمية
???? الإمام أحمد بن حنبل:
- قاتل الجهمية في مسألة خلق القرآن في محنة عظيمة.
- قال عنهم: "من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر".
???? الإمام أبو حنيفة:
- كفّر الجهم وقال: "من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر".
???? الإمام الذهبي:
- وصف الجهم بأنه "المتكلم الضال، رأس الجهمية وأساس البدعة" (سير أعلام النبلاء).
???? ابن تيمية:
- قال: "ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات والجبر والإرجاء كان في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم" (الفتاوى الكبرى).
???? ابن القيم:
- قال في الصواعق المرسلة: "أول من عارض الوحي بالرأي هم الجهمية، وهم مع قلتهم كانوا أفسد الناس رأيًا وأبعدهم عن النصوص".
- قاتل الجهمية في مسألة خلق القرآن في محنة عظيمة.
-
أثر الجهمية في الفكر الإسلامي
- مهدت الجهمية الطريق لظهور المعتزلة الذين تبنوا القول بخلق القرآن ونفي الصفات.
- كما تأثر بهم بعض الأشاعرة في مسائل التأويل والتنزيه العقلي، وإن كانوا وسطًا بين الجهمية والمثبتة.
- لذا قال أهل السنة: كل من نفى الصفات أو أولها تأويلًا باطلًا ففيه شوب من الجهمية.
- مهدت الجهمية الطريق لظهور المعتزلة الذين تبنوا القول بخلق القرآن ونفي الصفات.
-
الخاتمة
الجهمية تمثل المدرسة الأولى للتعطيل العقلي في الإسلام، وقد تصدى لها علماء السلف بكل قوة، دفاعًا عن نقاء العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة، حتى صار ذكرها مرادفًا للضلال العقدي في منهج السلف.
قال الله تعالى:
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات: 180-182].