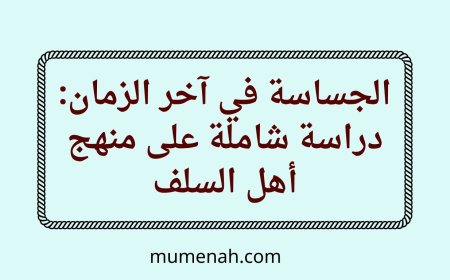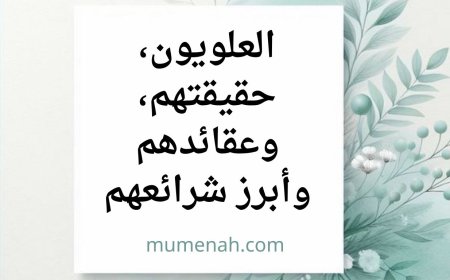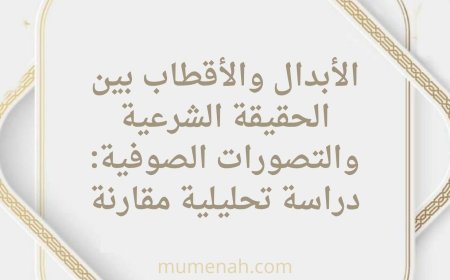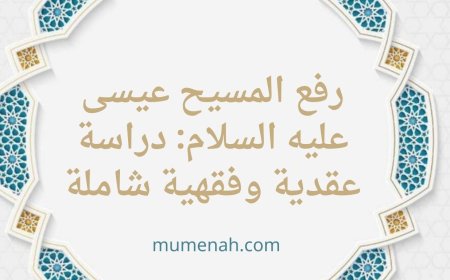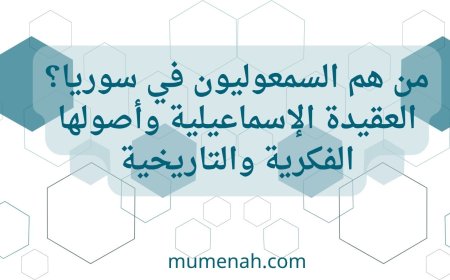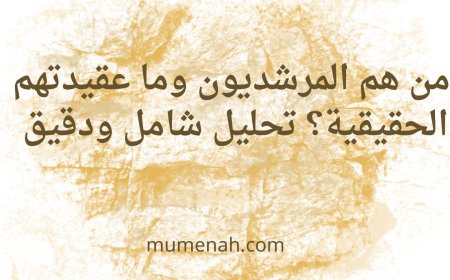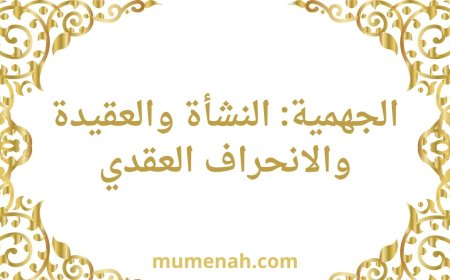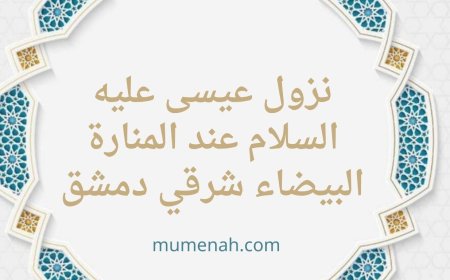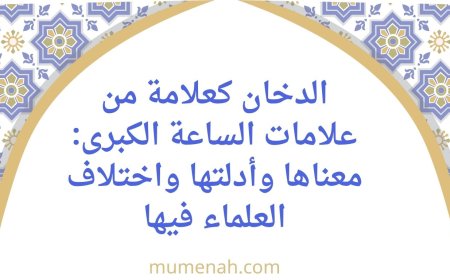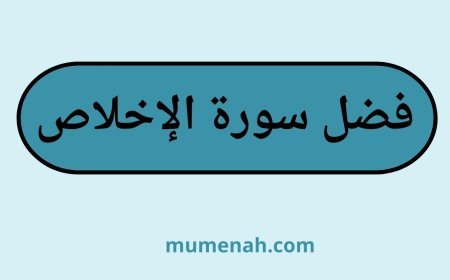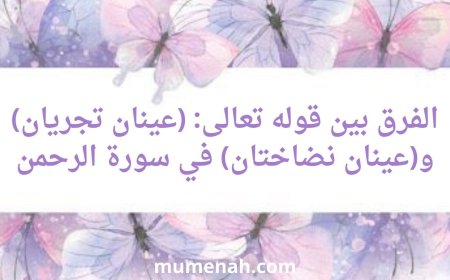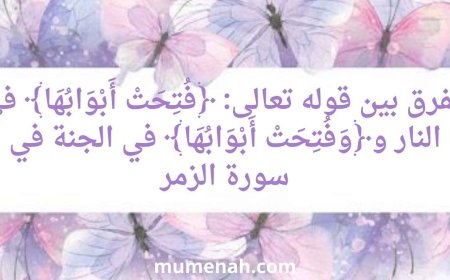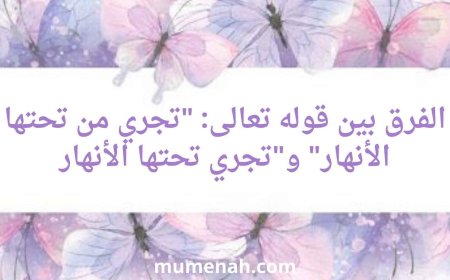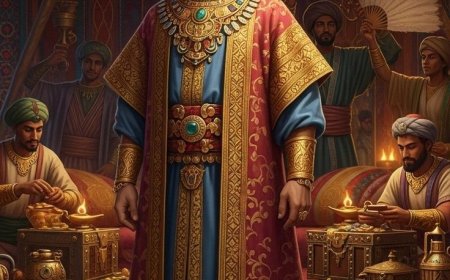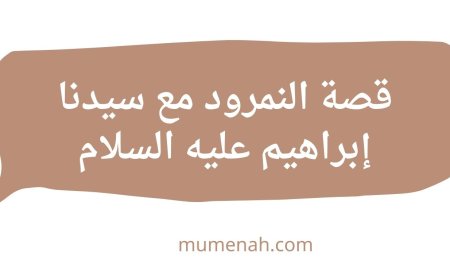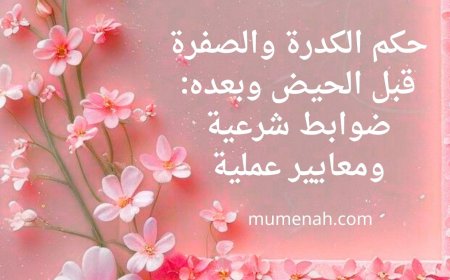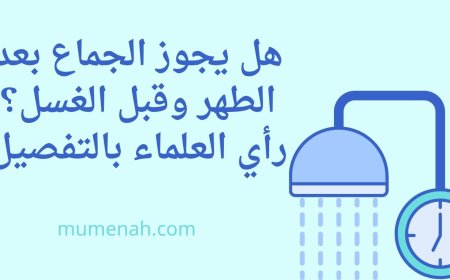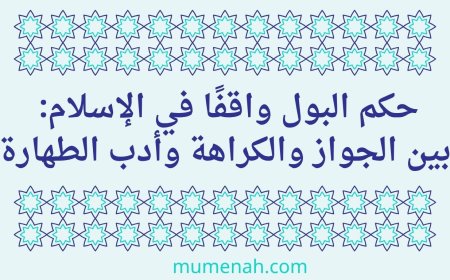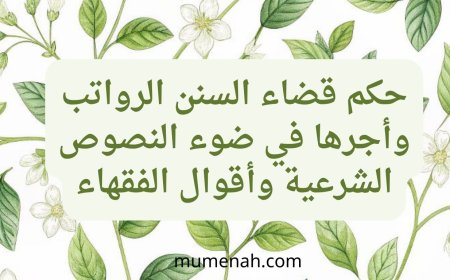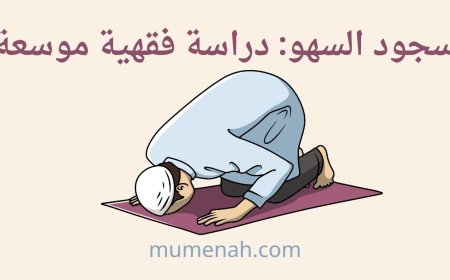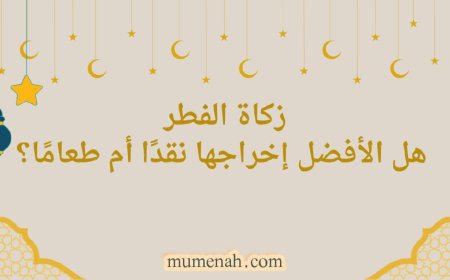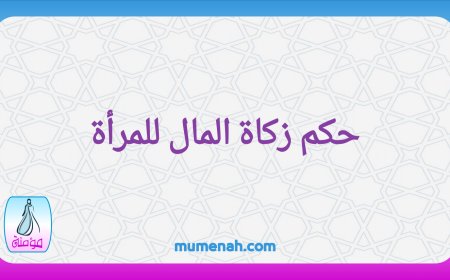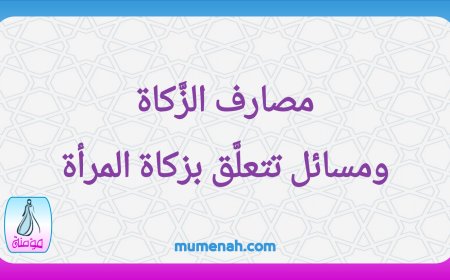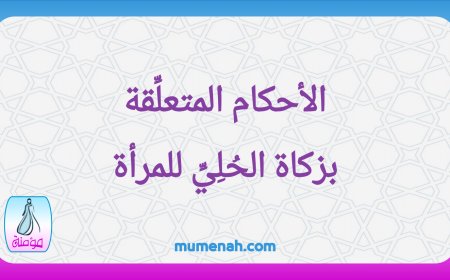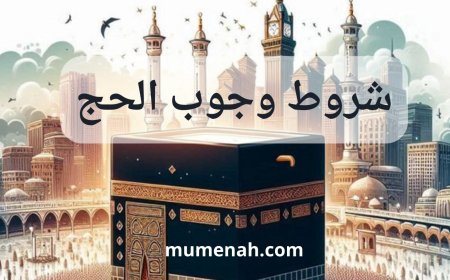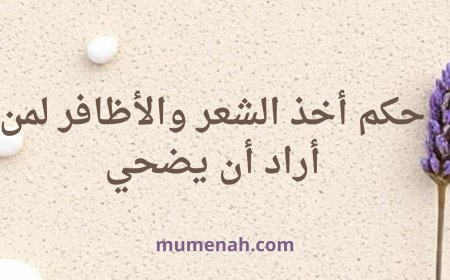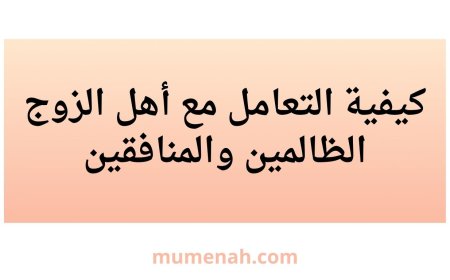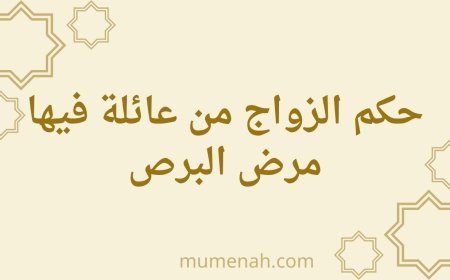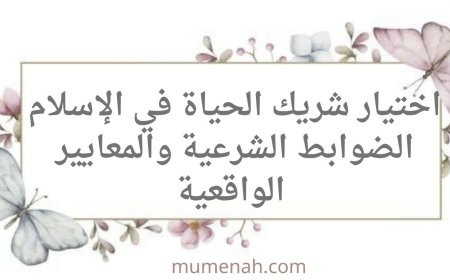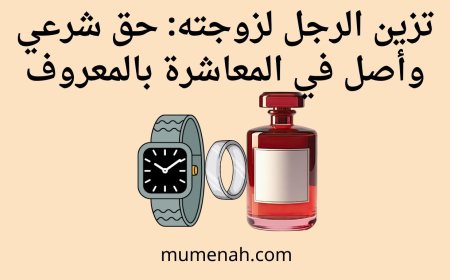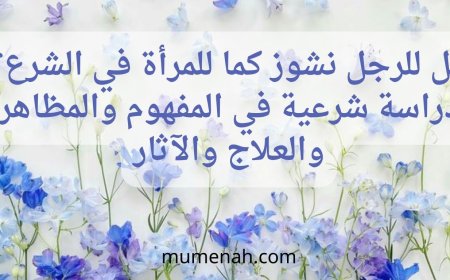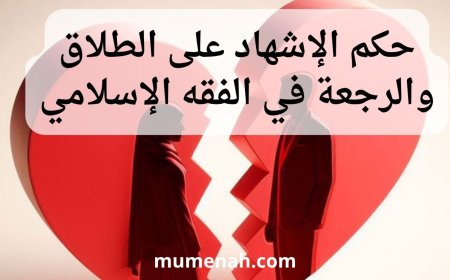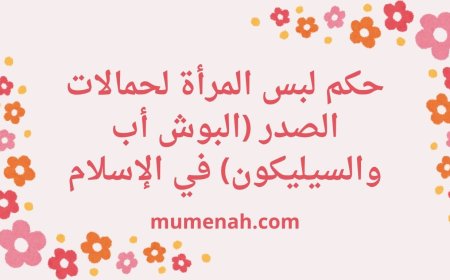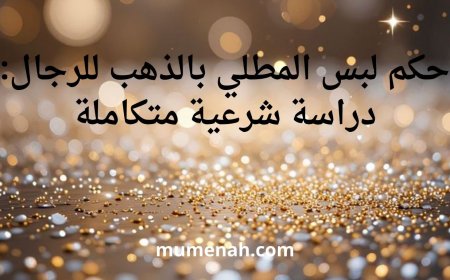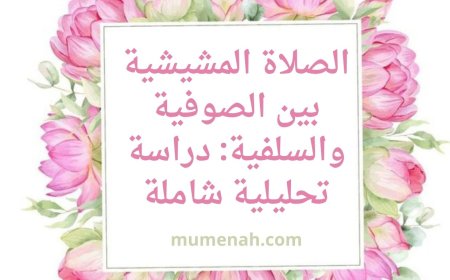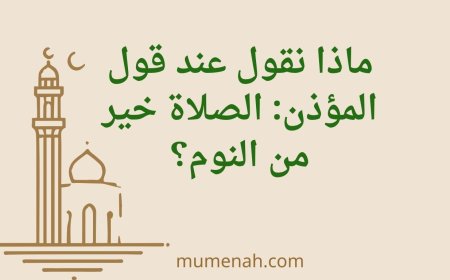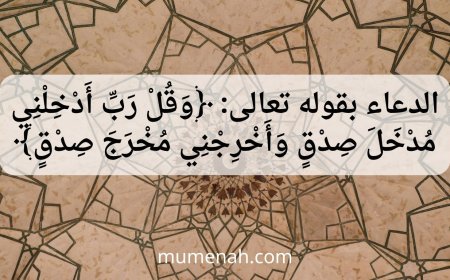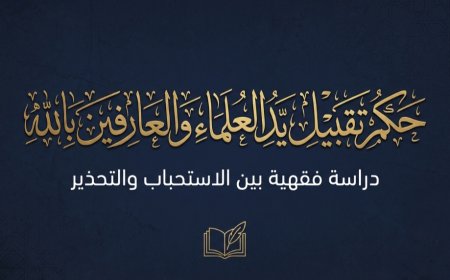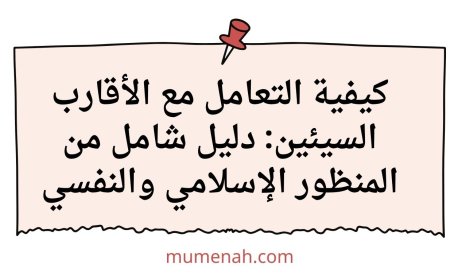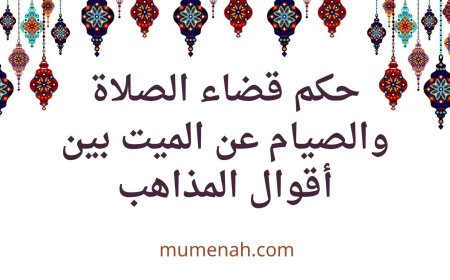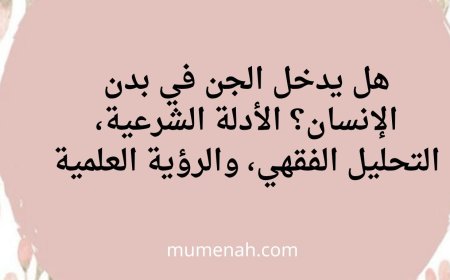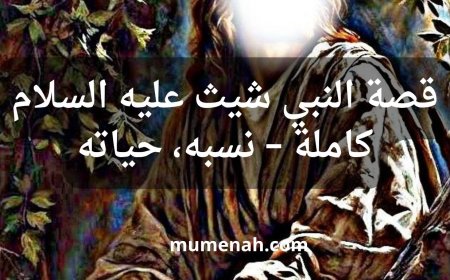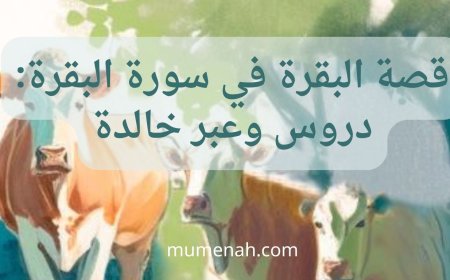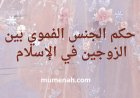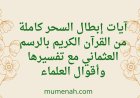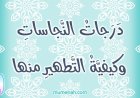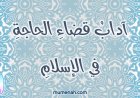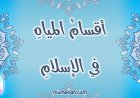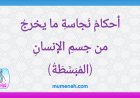قصة ذي القرنين في القرآن الكريم
قصة ذي القرنين كما وردت في سورة الكهف، مع عرض تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي، وتحليل هوية ذي القرنين بين الإسكندر الأكبر وكورش الفارسي، واستخلاص الدروس التربوية والقيادية من القصة.
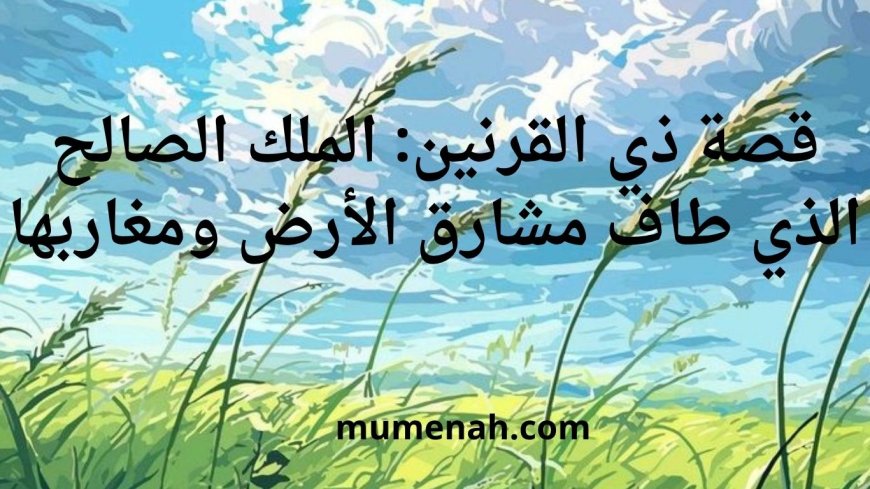
-
مقدمة
تُعد قصة ذي القرنين من أبرز القصص القرآنية التي وردت في سورة الكهف، وجاءت في سياق الرد على أسئلة قريش بإيعازٍ من علماء أهل الكتاب، لاختبار صدق النبي محمد ﷺ. وقد شكلت هذه القصة محورًا عميقًا للتأمل في مفاهيم التمكين، والعدل، والدعوة إلى الله، وحسن استخدام الأسباب، كما أثارت نقاشات ممتدة حول هوية هذا القائد وأبعاد رحلاته. وبين المفسرين القدماء والباحثين المعاصرين، تتنوّع الرؤى وتُظهر ثراء النص القرآني في تقديم نموذج الحاكم العادل والعبد الصالح في آنٍ واحد.
-
السياق القرآني للقصة
جاء ذكر ذي القرنين في سورة الكهف، في الآيات (83-101)، بعد قصّة أصحاب الكهف. وتبدأ القصة بالآية:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَآتِلُوْاْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: 83]
وهذا يدل على أن الخبر الذي سيُروى ليس تفصيلًا تاريخيًا صرفًا، وإنما هو "ذكر" فيه العبرة والهداية.ويُشير قول الله: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى منحة ربانية عظيمة؛ فقد كان ذا القرنين قائدًا مُمَكَّنًا، جمع بين القوة والعلم، وبين التمكين الأرضي والهدى الرباني. كما يُظهر قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ أنه أُوتي وسائل القوة والمعرفة التي أهّلته لتحقيق أهدافه، مما يجعله مثالًا يحتذى في القيادة المسؤولة.
-
معالم رحلات ذي القرنين
الرحلة إلى مغرب الشمس
في هذه الرحلة، بلغ ذي القرنين أقصى نقطة غربية مأهولة، فرأى الشمس تغرب كأنها تدخل في عينٍ حمئة – أي بحيرة ذات طين أسود – كما في قوله:
﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الكهف: 86]
وقد فسّرها المفسرون بأن المقصود هو المنظور البصري، لا أن الشمس تغرب فعلًا في العين.وفي هذا الموضع وجد قومًا، فخيّره الله في معاملتهم:
﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾
فأجاب بميزان العدل: يعاقب الظالم، ويكرم المحسن.2. الرحلة إلى مطلع الشمس
ثم سلك طريقًا آخر إلى الشرق:
﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ [الكهف: 89-90]
وصل إلى قومٍ يعيشون في بيئة لا تحجب عنهم الشمس، وربما كانوا بدائيين أو يسكنون السهول المفتوحة دون مظلات أو مبانٍ. ولم تذكر الآيات تعاملًا خاصًا معهم، مما يشير إلى أن ذي القرنين استمر في دعوته دون تدخلٍ حربي.3. الرحلة إلى سد يأجوج ومأجوج
المحطة الثالثة والأخطر كانت بين جبلين:
﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ [الكهف: 93]
حيث وجد قومًا يشتكون من بطش يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه بناء سدٍّ يمنع تسللهم. فرفض أن يأخذ منهم أجراً، وقال:
﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ [الكهف: 95]
ثم أمرهم بالمشاركة العملية، وبنى سدًّا حديديًا نحاسيًا لا يمكن تجاوزه أو نقبه، وصفه القرآن بـ:
﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: 97]
وكان إنجازه هذا من أبرز صور القيادة التقنية والعسكرية والعدلية. -
تفسير العلماء لأبعاد القصة
اعتمد المفسرون على الأحاديث والآثار في شرح شخصية ذي القرنين، مع تنوّع الروايات:
1. ابن كثير
ينقل عدة روايات، منها أنه عبد صالح مُمكَّن في الأرض، ويشير إلى أن تسميته جاءت من "طَعنتين" على قرنيه. ويعرض آراء عن كونه الإسكندر الأكبر أو ملكًا صالحًا من حمير.
2. الطبري
يروي عن وهب بن منبّه أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، وكان له قرنان نحاسيان، وجال في الأرض داعيًا إلى التوحيد.
3. القرطبي
ينقل آراء الصحابة والتابعين، ويؤكد أن ذي القرنين كان ملكًا عادلاً دعَا إلى الله، ويعرض أقوالًا عن أصله المصري أو اليمني.
4. الفخر الرازي
تبنّى نظرية أن ذي القرنين هو الإسكندر الأكبر (ابن فيليبوس)، مستدلًا بانطباق أوصاف الملك الواسع عليه.
-
من هو ذي القرنين بحسب المفسرين
ظلّ تحديد هوية ذي القرنين محل خلاف بين العلماء والباحثين:
الرأي الأول: الإسكندر الأكبر
وهو الرأي الكلاسيكي الذي اعتمدته كتب التفسير، بدعوى أن الإسكندر غزا الشرق والغرب، وبنى سدودًا وقلاعًا، واشتهر بقرنين في صورته (تاج).
الرأي الثاني: كورش الفارسي (قورش)
رجّحه بعض الباحثين المعاصرين كالسيد قطب والمودودي، مستندين إلى نصوص التوراة (سفر أشعيا)، وكون كورش ملكًا عادلًا حرر بني إسرائيل، ويُعتبر قد بنى سدًا حقيقيًا في جبال القوقاز.
لكن لا يوجد نص صريح في القرآن أو السنة يُحسم به هذا الجدل، ولهذا تبقى الشخصية رمزية تربوية، بغض النظر عن التحديد الدقيق لها.
-
الأبعاد التربوية والدعوية في القصة
قصة ذي القرنين ليست مجرد سجلّ جغرافي أو سرد تاريخي، بل تحمل دروسًا عقدية وأخلاقية، منها:
· حسن استخدام الأسباب:
﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾، دليل على أن التمكين لا يُغني عن العمل والسعي.· التواضع:
رفض المقابل المادي من القوم لبناء السد:
﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾· العدل في الحكم:
عامل الناس بالميزان الرباني:
﴿فَأَمَّا مَن ظَلَمَ... وَأَمَّا مَنْ آمَنَ...﴾· القيادة الربانية:
يمثل ذي القرنين نموذجًا للحاكم العادل الذي يجمع بين القوة والرحمة والدعوة.· الاستعداد للمستقبل:
بناء السدّ لم يكن لردّ خطر حاضر فقط، بل تحسُّبًا لمستقبل أمة، وهو درس في التخطيط والإدارة. -
تأملات في فلسفة القصة
تمثل قصة ذي القرنين نموذجًا قرآنيًا متوازنًا للسلطة: قائد قوي ولكن خاضع لأمر الله، يستثمر قوته في نشر العدل ورفع الظلم، ويؤسس لثقافة التمكين المبني على الهداية لا الجبروت. وهي قصة تتكرر رمزيًا في كل زمن، حيث تُقدَّم للمسلمين وللعالم المعاصر نموذجًا مغايرًا للحكم القائم على الاستبداد أو الضعف.
-
الخاتمة
إن قصة ذي القرنين في القرآن ليست فقط قصة "ملكٍ وسدٍّ وقومٍ"، بل قصة التمكين بالحق، والقوة بالعدل، والعلم بالتواضع. وقد وظّفها القرآن ضمن سياقٍ أعظم، هو الهداية الإلهية والرد على المشككين برسالة النبي ﷺ. وبينما تبقى هوية ذي القرنين مسألة خلافية، فإن جوهر القصة واضح ومُلهم: الإنسان حين يُمَكَّن بإرادة الله ويقود بدعوة الحق، يصبح أداةً للإصلاح والنفع العام.
-
مقالات ذات صلة