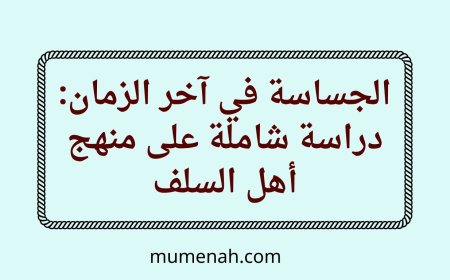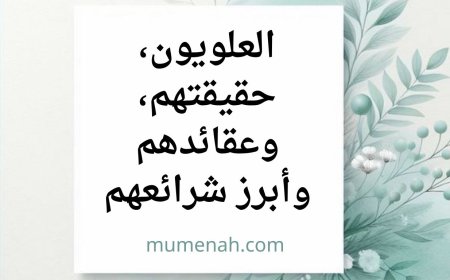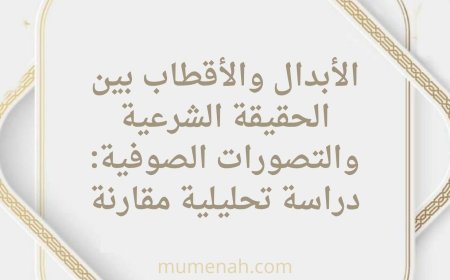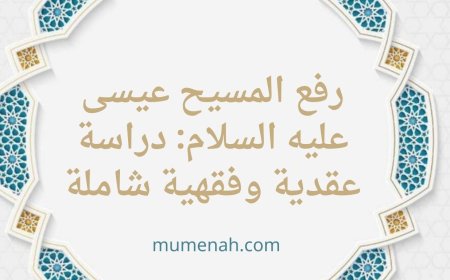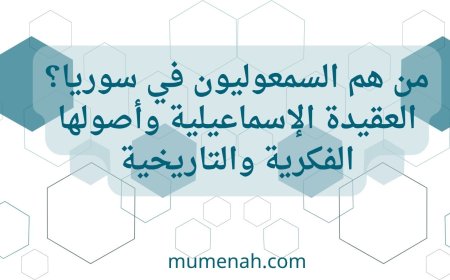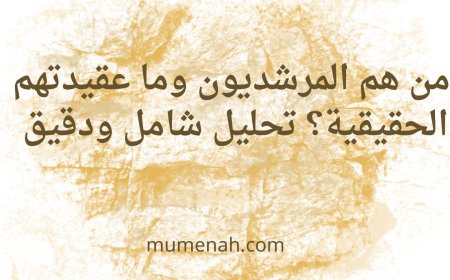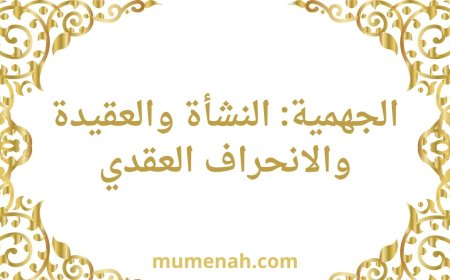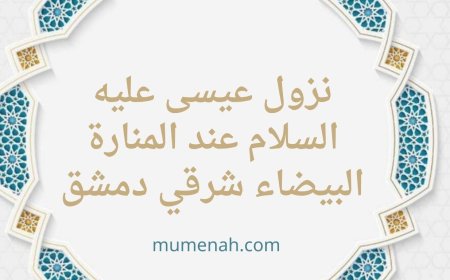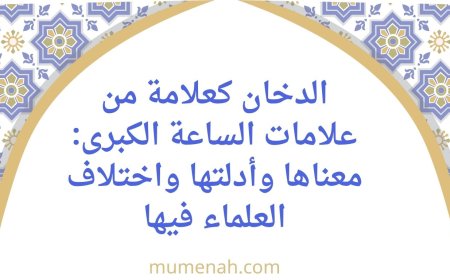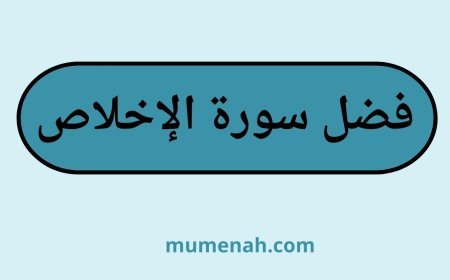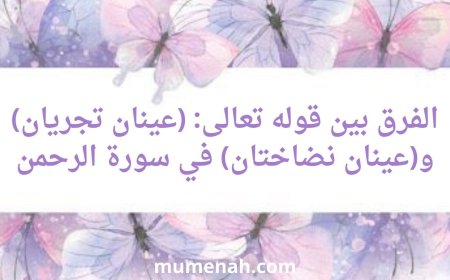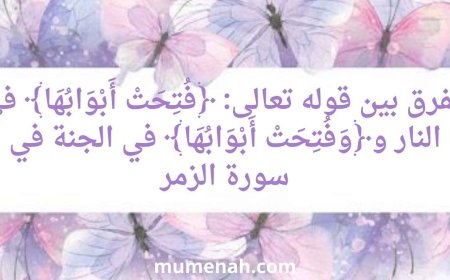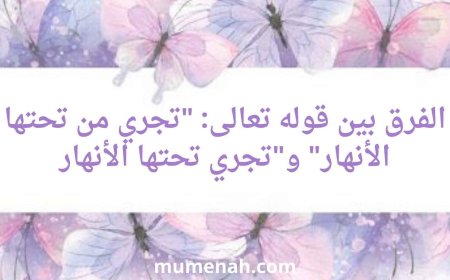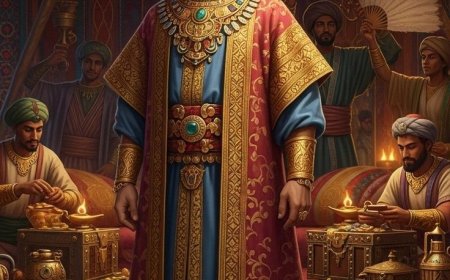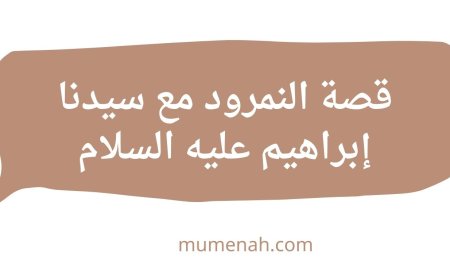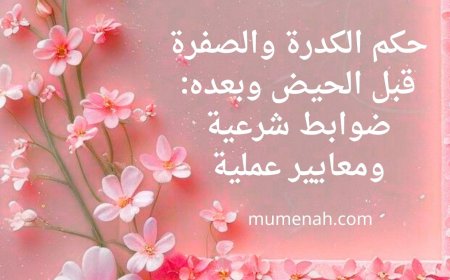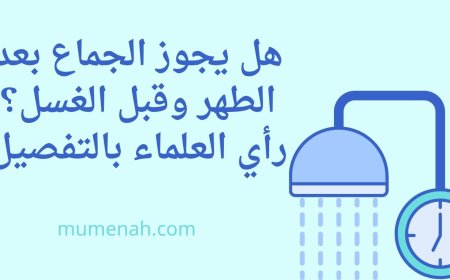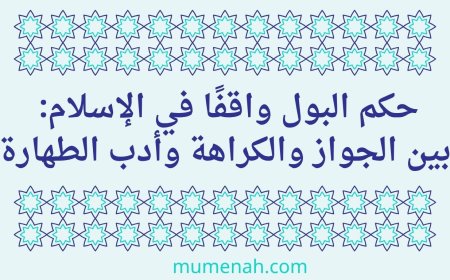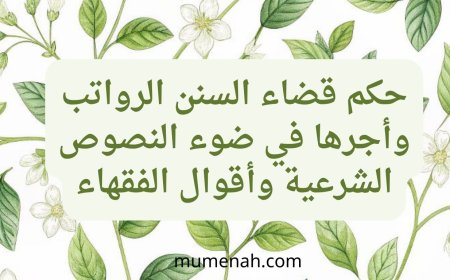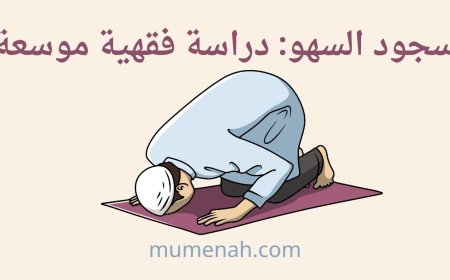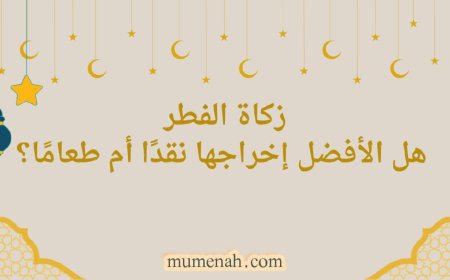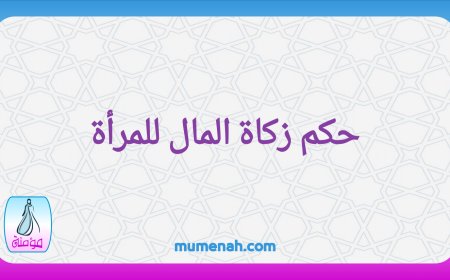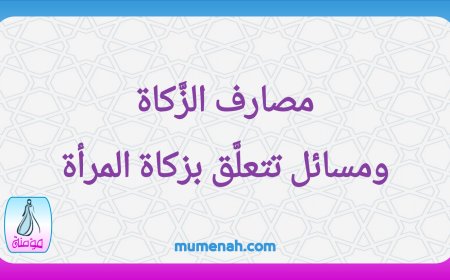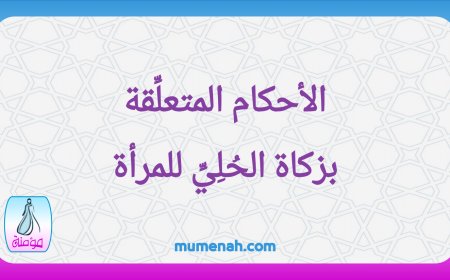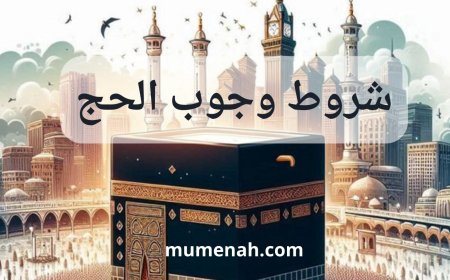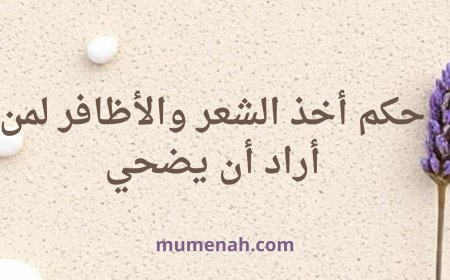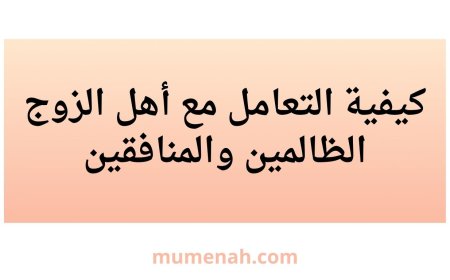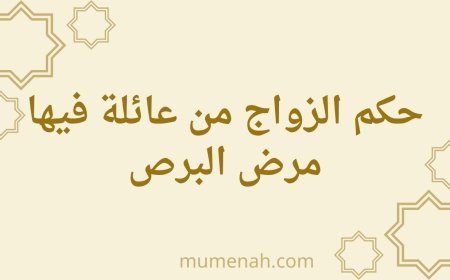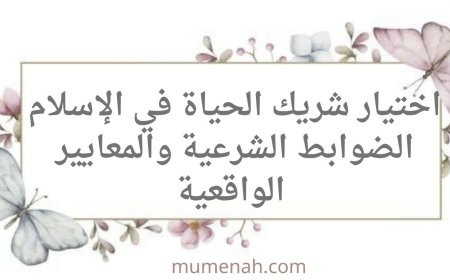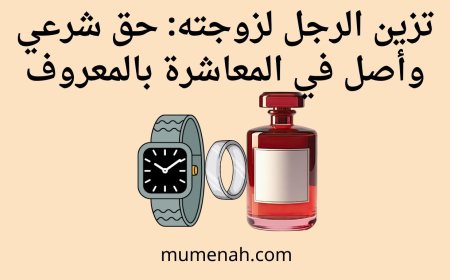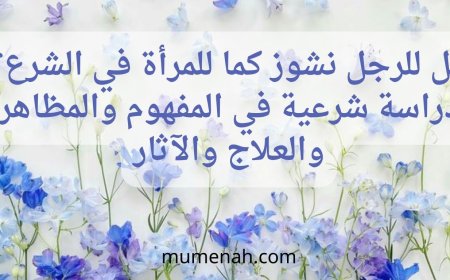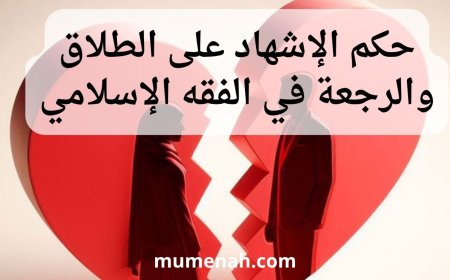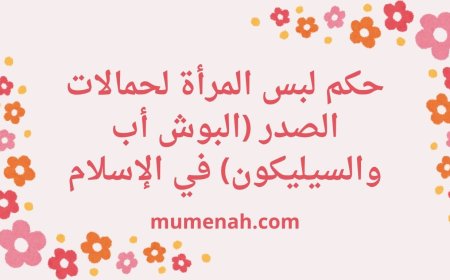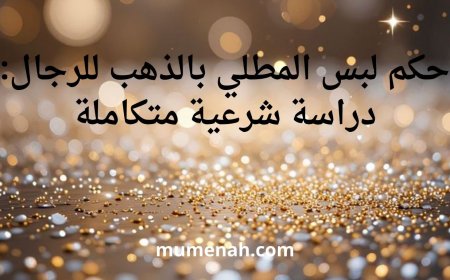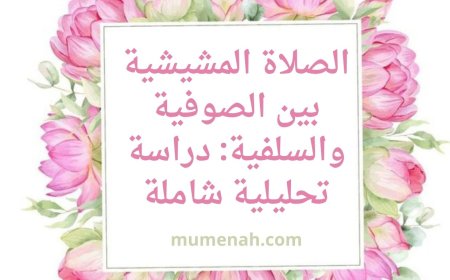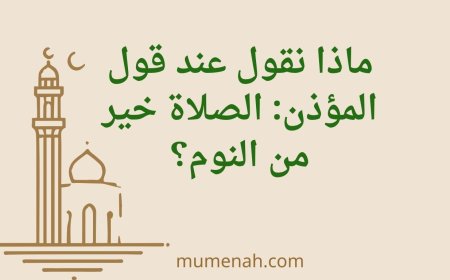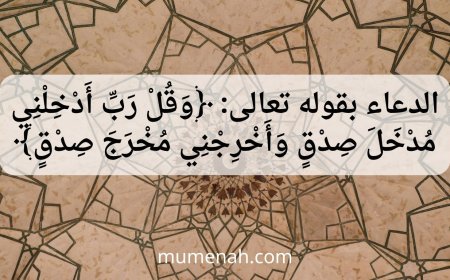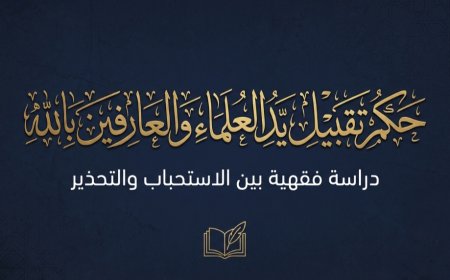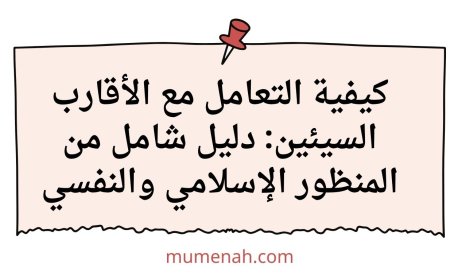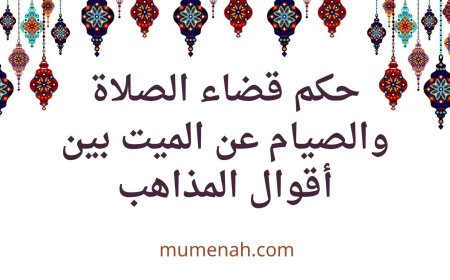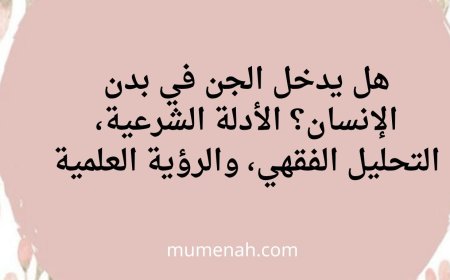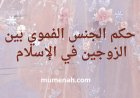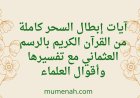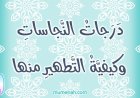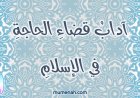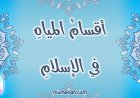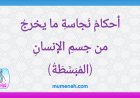ما هي التقية في الإسلام وهل يستخدمها أهل السنة؟
تعرف على معنى التقية في الإسلام وأصلها في القرآن الكريم، وهل يستخدمها أهل السنة أم لا؟ توضح المقالة الفرق الجوهري بين مفهوم التقية عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الإمامية، مع الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وآراء العلماء، بأسلوب فقهي مبسط ومتكامل.

-
مقدمة
تُعدّ التقية من المصطلحات التي دار حولها كثير من الجدل بين المسلمين، نظراً لاختلاف المفهوم والممارسة بين الفرق الإسلامية. فهي عند بعض الطوائف ركن من أركان الدين لا يقوم الإيمان إلا بها، بينما يراها أهل السنة والجماعة رخصة شرعية تُباح في حالات الضرورة القصوى، حماية للنفس أو العرض أو المال من ضررٍ محقق.
في هذا المقال نتناول مفهوم التقية تعريفًا، وأصلها في القرآن الكريم، وموقف أهل السنة منها، مع بيان الفرق الجوهري بينها وبين مفهوم التقية عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، بما يجعل القارئ على بيّنة من حقيقتها وضوابطها الشرعية. -
تعريف التقية لغة واصطلاحًا
- لغةً: مأخوذة من الوقاية، وهي الحذر من الشيء الذي يُخاف ضرره، فيُقال: اتّقى الشيء، أي تجنّبه وحمى نفسه منه.
- اصطلاحًا: عرفها العلماء بأنها: إظهار خلاف ما يُبطنه المرء اتقاءً لضررٍ متوقّعٍ من عدوٍّ أو ظالم، مع بقاء القلب مطمئنًا بالإيمان.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
"التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية"
(أحكام أهل الذمة، 2/1038). - لغةً: مأخوذة من الوقاية، وهي الحذر من الشيء الذي يُخاف ضرره، فيُقال: اتّقى الشيء، أي تجنّبه وحمى نفسه منه.
-
أصل التقية في القرآن الكريم
ورد أصل التقية في القرآن الكريم في قوله تعالى:
﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾
(آل عمران: 28)فهذه الآية هي الأساس الذي بنى عليه العلماء مشروعية التقية في حالات الخوف والاضطرار. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
"أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته".
فالتقية هنا رخصة شرعية مؤقتة عند وجود الخوف من الأذى أو القتل، وليست أصلاً من أصول الدين، بل هي استثناء من الأصل الذي هو وجوب إظهار الحق والبراءة من الباطل.
-
موقف أهل السنة والجماعة من التقية
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأصل في التقية المنع، ولا تُباح إلا في حال الضرورة، كالإكراه على الكفر أو القتل أو الإيذاء الشديد الذي لا يُحتمل.
قال الإمام القرطبي في تفسيره:"التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، ولم يُنقل ما يخالف ذلك إلا عن معاذ بن جبل ومجاهد".
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (13/186):
"مذهب جمهور علماء أهل السنة أن الأصل في التقية هو الحظر، وجوازها ضرورة، فتُباح بقدر الضرورة".
فالتقية عند أهل السنة ليست سلوكًا دائمًا أو سياسة عامة، بل هي رخصة محدودة في ظروف استثنائية، تُقدّر بقدرها، ويُشترط لوقوعها ما يلي:
1. وجود خوف حقيقي معتبر من أذى جسيم أو ضرر محقق.
2. عدم وجود وسيلة أخرى لدفع الضرر سوى التقية.
3. أن لا تؤدي التقية إلى ضررٍ أعظم من الضرر المراد دفعه.
4. أن تبقى النية صافية والإيمان ثابتًا في القلب.
قال الله تعالى:
﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾
(النحل: 106)وهذه الآية دليل صريح على جواز التقية عند الإكراه، فقد نزلت في الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أُكره على كلمة الكفر بعد أن عُذّب هو وأبواه، فأنزل الله العذر له ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان.
-
الفرق بين التقية عند أهل السنة وعند الشيعة
هنا يتجلّى الفارق الجوهري بين العقيدتين:
الجانب
التقية عند أهل السنة والجماعة
التقية عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية
الحكم الشرعي
رخصة اضطرارية مؤقتة
أصل من أصول الدين وركن من أركانه
المجال التطبيقي
مع الكفار أو الظالمين عند الضرورة
مع المسلمين، خاصة أهل السنة
الغاية منها
دفع الضرر والخوف على النفس أو الدين
إخفاء المعتقد ونشر المذهب سرًا
الحدّ والضوابط
تُباح بقدر الضرورة وتنتهي بانتهائها
واجبة حتى ظهور “الإمام الغائب”
الموقف الأخلاقي
لا يُستحل بها الكذب إلا لضرورة قصوى
الكذب والخداع يعدان عبادة عندهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"الرافضة يجعلون التقية من أصول دينهم، وهي شعار النفاق؛ فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا حقيقة النفاق"
(مجموع الفتاوى، 13/263).وقال أيضًا:
"وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم يقرون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق"
(منهاج السنة النبوية، 1/30).فالتقية في مذهبهم عقيدة شاملة تشمل الممارسات الدينية والسياسية والاجتماعية، ويُعدّ تركها كترك الصلاة، كما صرّح بذلك ابن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات:
"اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة".
-
أمثلة من السيرة النبوية في جواز التقية عند الضرورة
جاءت شواهد عملية من السيرة النبوية تؤكد مشروعية التقية في حالات الضرورة دون أن تكون أصلاً في الدين:
1. قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أُكره على كلمة الكفر، فأنزل الله فيه:
﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.
وقد أقرّه النبي ﷺ على فعله وقال له:"إن عادوا فعد" (رواه الحاكم وصححه).
2. كتمان إيمان المؤمن من آل فرعون كما قال تعالى:
﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ (غافر: 28)
فإخفاء إيمانه كان تقية خوفًا من بطش فرعون وجنده.فهذه النماذج تُبيّن أن التقية استثناء اضطراري، وليست سلوكًا عامًا، ولا وسيلة دائمة للتعامل مع الناس أو نشر الدين.
-
الضوابط الشرعية لاستخدام التقية
وضع الفقهاء شروطًا دقيقة لضبط استعمال التقية حتى لا تُتخذ ذريعةً للكذب أو الخداع، ومن أبرزها:
1. أن يكون الضرر محققًا أو يغلب على الظن وقوعه.
2. أن لا يُفضي استعمال التقية إلى ضررٍ بغيره من المسلمين.
3. أن تُقدّر بقدرها، فلا يُتوسع فيها بغير ضرورة.
4. أن تكون نية المسلم واضحة بأنه إنما يفعلها دفعًا للضرر لا اتباعًا لهوى أو مصلحة دنيوية.
5. أن تنتهي بزوال السبب الذي أوجبها.
قال الله تعالى:
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنعام: 145)
وهذا تأصيل قرآني بأن الرخصة لا تُباح إلا في حدود الضرورة دون تجاوز.
-
التقية بين العزيمة والرخصة
التقية رخصة لا عزيمة، فمن اختار أن يتحمّل الأذى في سبيل الله دون أن يستعملها فهو أعظم أجرًا وأرفع مقامًا.
قال ابن بطّال:"أجمعوا على أن من أُكره على الكفر واختار القتل فهو أعظم أجرًا عند الله".
فمن صبر واحتسب، ووقف موقف الثبات على الإيمان، فقد نال درجة الصدّيقين والشهداء، كما قال الله تعالى:
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب: 23)
-
خاتمة
يتضح مما سبق أن التقية في الإسلام رخصة استثنائية مشروعة عند الضرورة، تُستعمل لحفظ النفس من الهلاك أو الأذى الجسيم، دون أن تكون منهجًا دائمًا أو سلوكًا عامًّا. أما التقية عند الشيعة الإمامية فقد تحوّلت إلى أصل من أصول العقيدة، تُستخدم حتى مع المسلمين أنفسهم، وتُمارس كجزء من الدين، وهو ما يخالف تمامًا مقاصد الشريعة الإسلامية التي قامت على الصدق والوضوح والعدل.
فشتّان بين من يجعل التقية رخصة اضطرار، ومن يجعلها شعارًا دائمًا للنفاق والكتمان.
قال ابن تيمية رحمه الله:"التقية شعار المنافقين، وأصلها الكذب، ولا يجتمع الإيمان الصادق مع الكذب المتعمّد".
إن دين الله دين صدق وبيان، لا دين كتمانٍ وخداع، والحق أبلج لا يحتاج إلى التقية إلا عند الضرورة القصوى التي تُقدّر بقدرها، حفظًا للنفس من الهلاك، مع بقاء القلب على الإيمان، وصدق التوجه إلى الله تعالى.