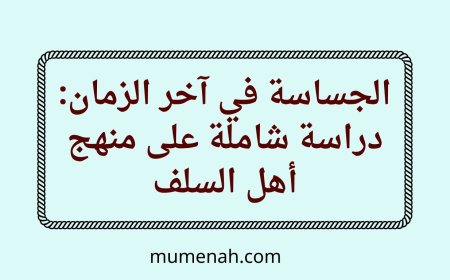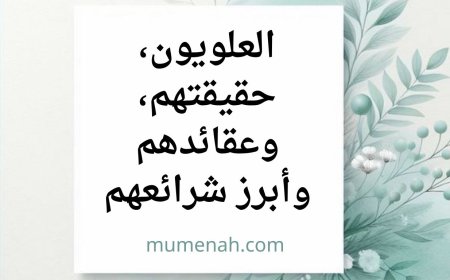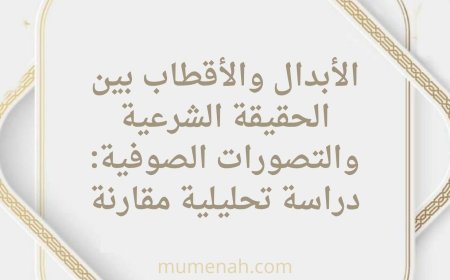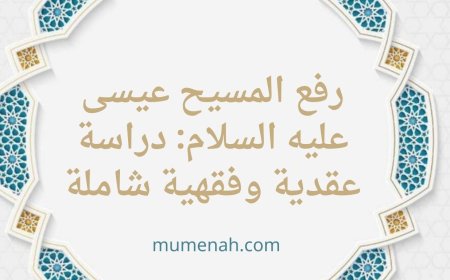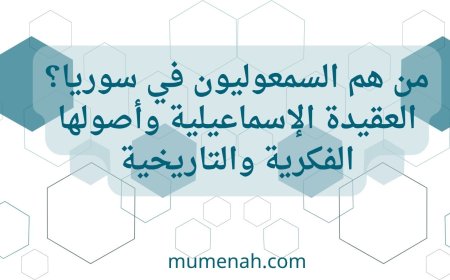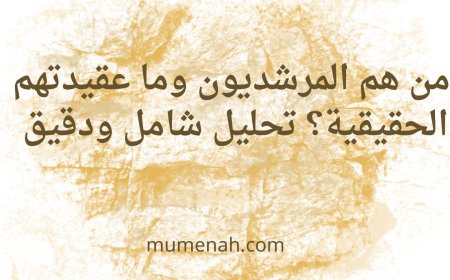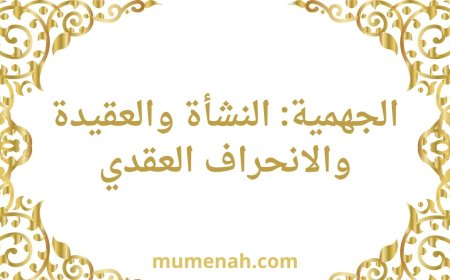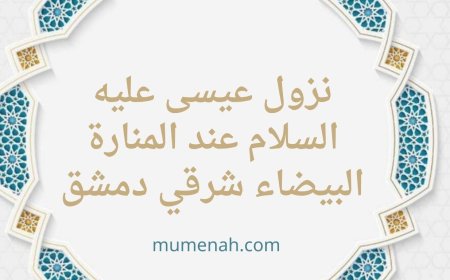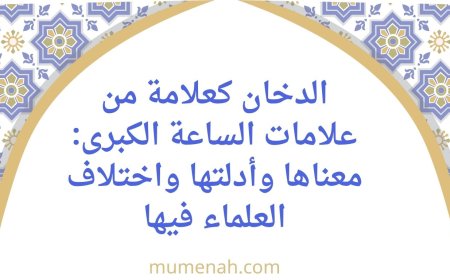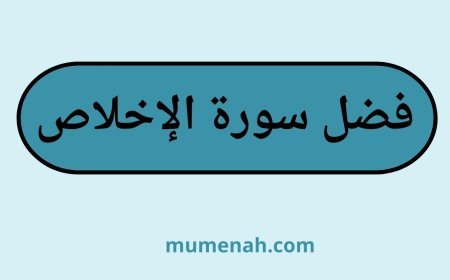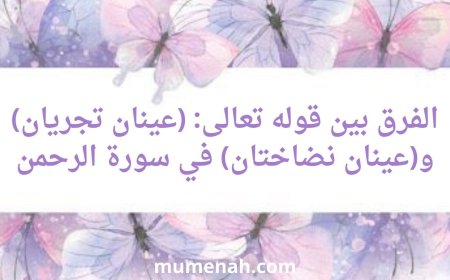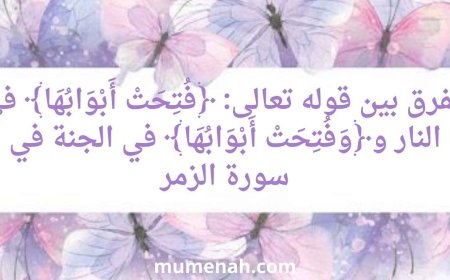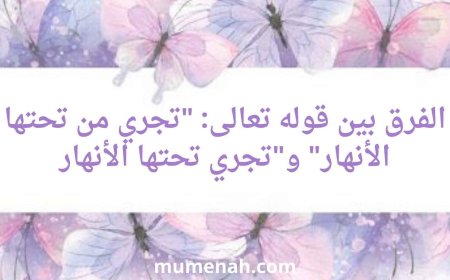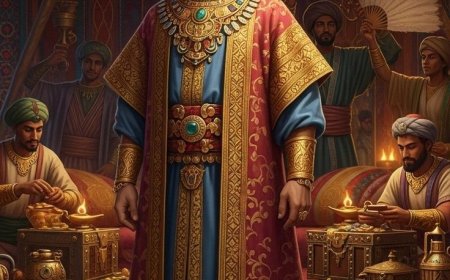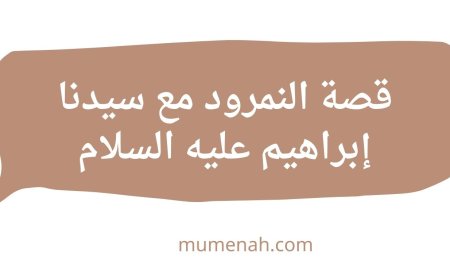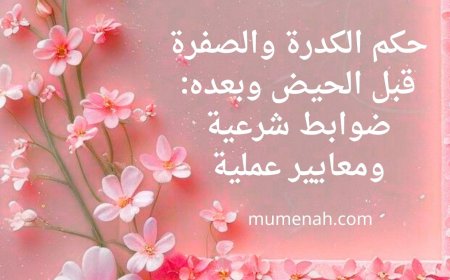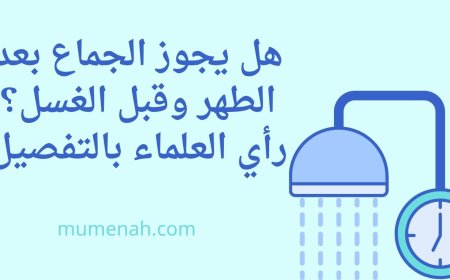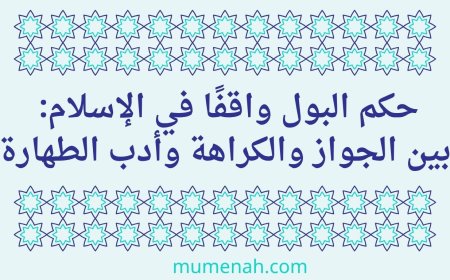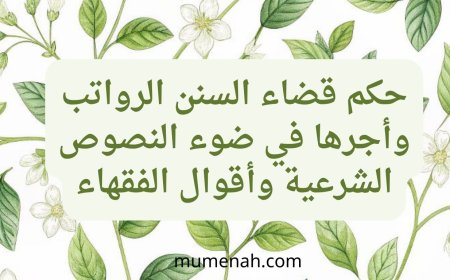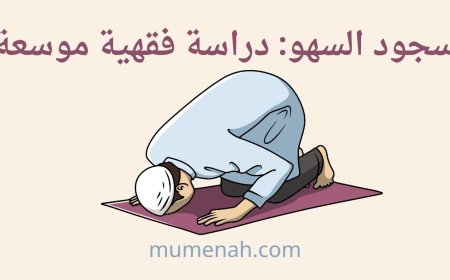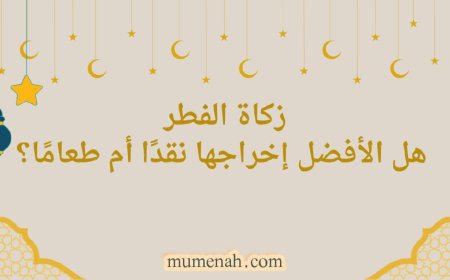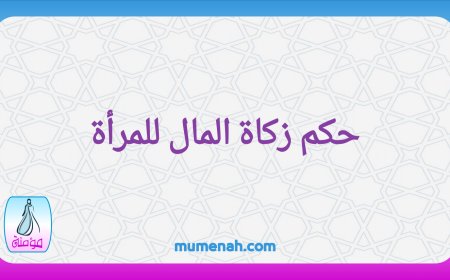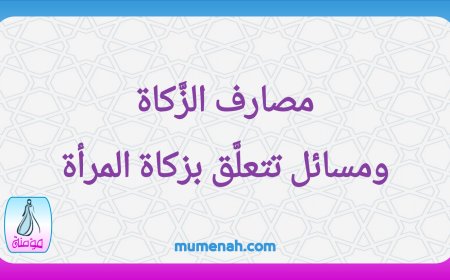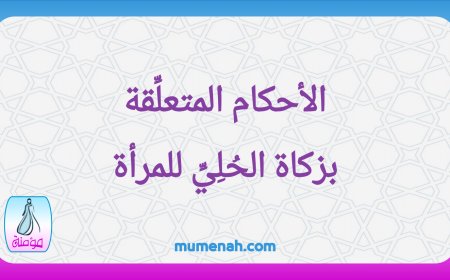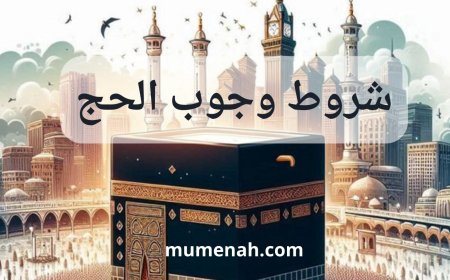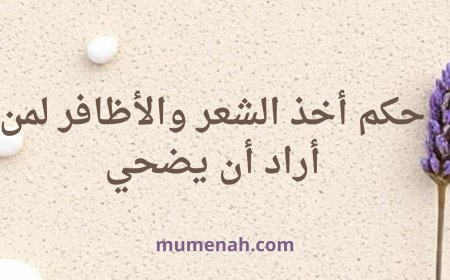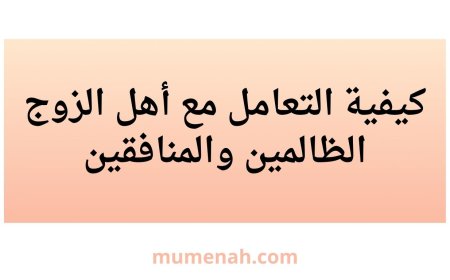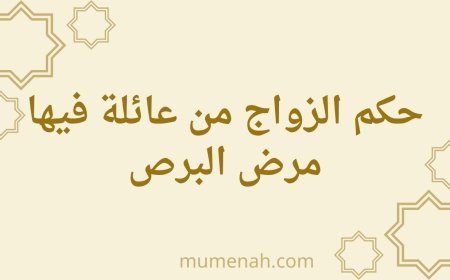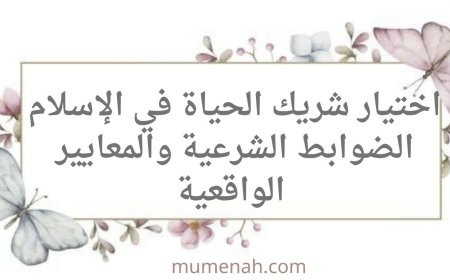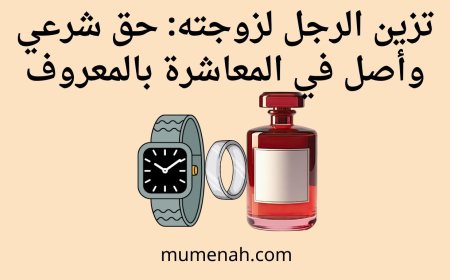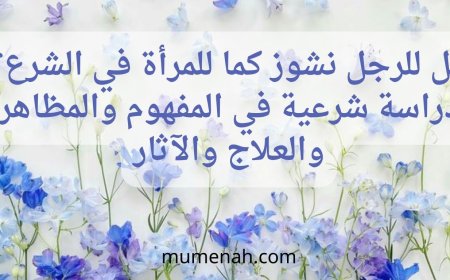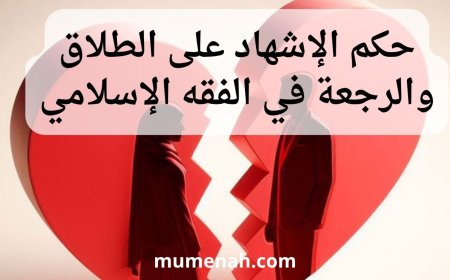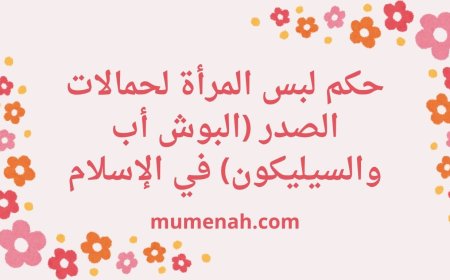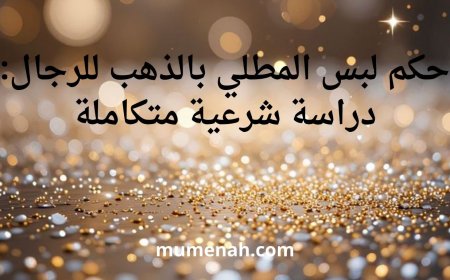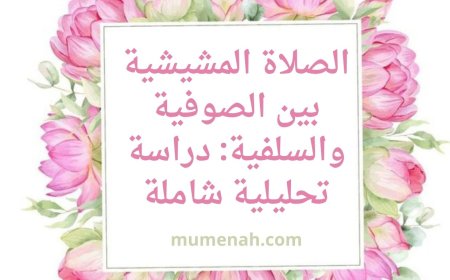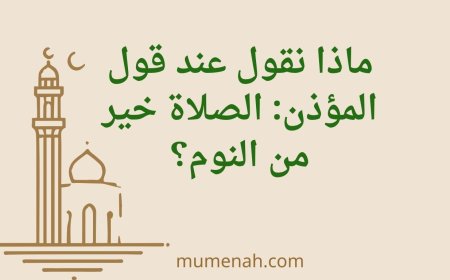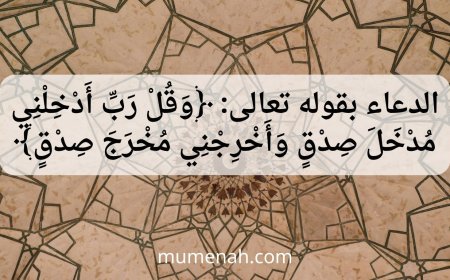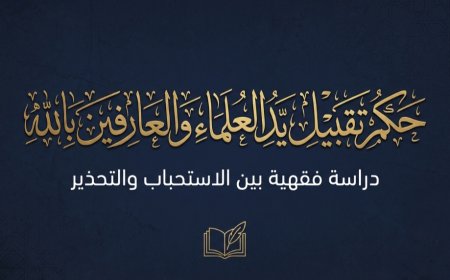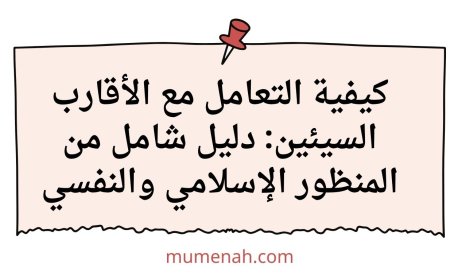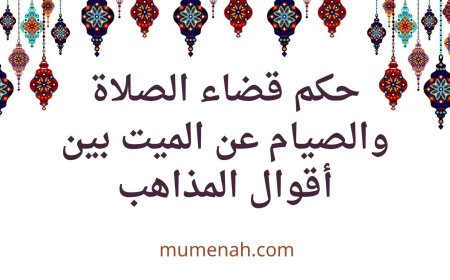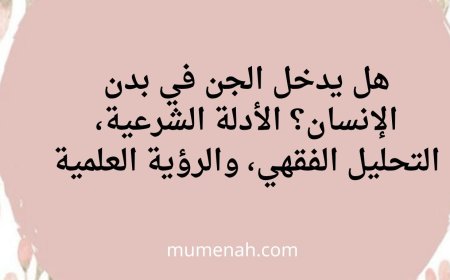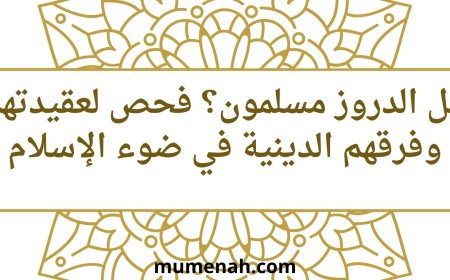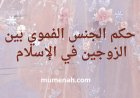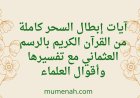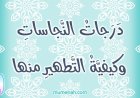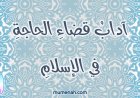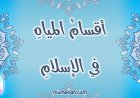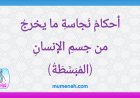معنى الجذب عند الصوفية: مفهومه ومراحله وأسراره في طريق السلوك الروحي
اكتشف المعنى الحقيقي لمصطلح الجذب عند الصوفية، وتعرّف على أنواعه ومراحله وعلاقته بالمحبة الإلهية والسلوك الروحي. تحليل شامل من مصادر موثوقة يوضح مفهوم الجذب في التصوف الإسلامي وأقوال كبار العارفين فيه.
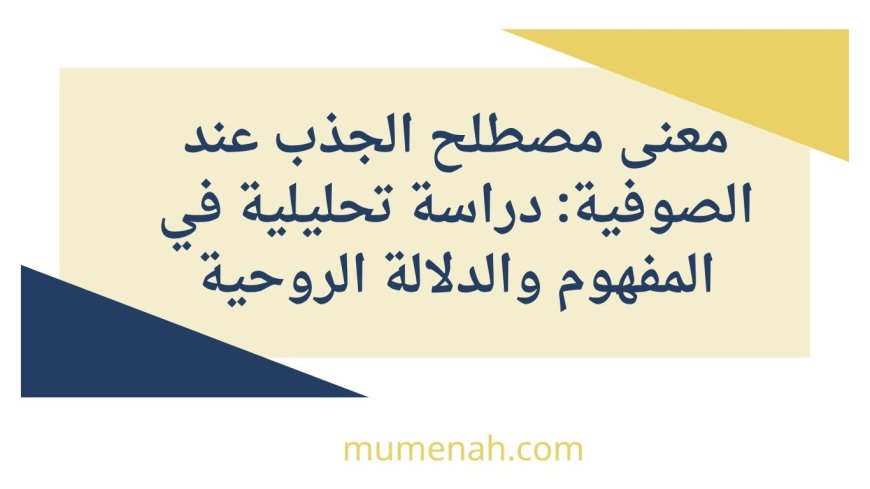
جدول المحتويات
- مقدمة
- الجذب لغة واشتقاقاً
- الجذب اصطلاحاً عند الصوفية
- تطوّر مفهوم الجذب في التراث الصوفي
- الفرق بين السلوك والجذب
- أنواع الجذب عند الصوفية
- المجذوب وصفاته
- الجذب والولاية عند الصوفية
- مواقف العلماء من مفهوم الجذب
- الجذب في ضوء القرآن والسنة
- البعد الفلسفي لمفهوم الجذب
- الجذب في التجربة الصوفية المعاصرة
- الجذب بين الإلهام والجنون
- الخاتمة
-
مقدمة
يُعدّ مصطلح «الجذب» من المصطلحات المحورية في الفكر الصوفي الإسلامي، لما ينطوي عليه من دلالات روحية عميقة تتصل بالعلاقة بين العبد وربّه. وقد شكّل هذا المفهوم أساسًا لعدد من التجارب الصوفية التي عبّرت عن معاني القرب الإلهي والاصطفاء الرباني. ورغم ما حُفّ به من غموض وتعدّد في التأويل، فإن الجذب ظلّ يشكّل أحد المفاتيح الأساسية لفهم التجربة الصوفية ومقاماتها العليا.
-
الجذب لغة واشتقاقاً
الجذب في اللغة مأخوذ من جَذَبَ، أي مدَّ الشيءَ واستلبه من موضعه. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: “الجيم والذال والباء أصلٌ واحدٌ يدلّ على مَدٍّ واستلابٍ”؛ ومنه قولهم: جذب الحبلَ أي شده إليه.
ويُقال: اجتذبه إذا أخذه بقوة، وجذبه على قلبه أي نحّاه عن حالٍ إلى حال. ومن هذه الدلالة اللغوية انطلق الصوفية ليعبّروا عن حركة روحية تنتقل فيها النفس من عالم الحسّ إلى عالم المعنى، ومن التعلّق بالمخلوق إلى التعلّق بالخالق. -
الجذب اصطلاحاً عند الصوفية
عرّف الصوفية الجذب بتعاريف عدّة، تتقاطع كلها حول معنى الاصطفاء الإلهي والاجتذاب الرباني للعبد إلى حضرته من غير تعبٍ أو سلوكٍ طويل.
- يقول الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء: “الجذب هو أن تدرك العنايةُ قلبَ العبد فتختطفه من عالم العادة إلى عالم الحقيقة”.
- وعرّفه القشيري في رسالته بقوله: “الجذب هو ملاحظة عناية الله للعبد بأن يهيّئ له الطريق إليه بلا كلفة ولا مجاهدة”.
- وقال ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية: “رُبَّ ساعٍ إلى الله، ورُبَّ من جذبه الله إليه، فأقامه في حضرته بلا تعبٍ ولا نصب”.
إذن فالجذب عند الصوفية هو فيضٌ ربانيّ يقع في القلب فيختصر الطريق، ويقرّب العبد من ربه بغير مجاهدةٍ أو سلوكٍ تقليديّ.
- يقول الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء: “الجذب هو أن تدرك العنايةُ قلبَ العبد فتختطفه من عالم العادة إلى عالم الحقيقة”.
-
تطوّر مفهوم الجذب في التراث الصوفي
ظهر مصطلح الجذب في بدايات التصوف الإسلامي في القرن الثالث الهجري، في أقوال أمثال الجنيد والترمذي والحارث المحاسبي، لكنه تبلور بوضوح في القرن الرابع عند الطوسي في اللمع، حيث تحدّث عن “جذب الأرواح إلى حضرة القدس”.
ثم تطوّر المفهوم عند السهروردي وابن عربي، فأصبح يشير إلى نوع من الفناء في الذات الإلهية، أو حالة الغيبة عن الكون بشهود المكوِّن.
وفي العصور اللاحقة، توسّع استخدام المصطلح في مدارس التصوف المغربي والمشرقي، وبرز التمييز بين «السلوك» و**«الجذب»** كطريقين متكاملين إلى الله. -
الفرق بين السلوك والجذب
يفرّق الصوفية بين طريقين للوصول إلى الله:
1. طريق السلوك:
وهو طريق المجاهدة والمراقبة والذكر والعبادة، يقطعه العبد بخطوات تدريجية. السالك يسير إلى الله بجهده، حتى يترقى في المقامات من التوبة إلى الفناء.2. طريق الجذب:
وهو طريق العناية والاصطفاء، حيث يجذب الله العبد إليه بلا مجاهدة منه، كما قال تعالى:{اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13].
فـ«الاجتباء» جذب، و«الإنابة» سلوك، كما فسر بعض أهل الإشارة.ويُقال إن بعض العباد «سلكوا حتى جُذبوا»، وآخرين «جُذبوا حتى سلكوا». فالأول مجتهدٌ في الطريق حتى نال الجذب، والثاني مفضَّلٌ بالعناية ابتداءً ثم سلك ببركتها.
-
أنواع الجذب عند الصوفية
يذكر الصوفية أن للجذب صوراً متعدّدة، منها:
1. الجذب الكلّي (الحقيقي):
وهو أن تُستلب الروح من عالم الحسّ تماماً، فيفقد المجذوب شعوره بالوجود المادي، ويغيب عن العالم في شهودٍ إلهيّ كامل. وقد وصفوه بـ“الاختطاف الرباني”.2. الجذب الجزئي (الناقص):
وهو أن تصيب العبد لمحة من التجلي الإلهي تجعله يغيب لحظة عن وعيه، ثم يعود، كمن يتذوق شيئاً من عالم الغيب ثم يرجع إلى وعيه.3. الجذب بعد السلوك:
وهو الذي يأتي ثمرةً لمجاهدة طويلة، فيكون كالعطاء الإلهي بعد الصبر على الطريق.4. الجذب المقرون بالبقاء:
وهو أن يجتمع في العبد حال الجذب مع بقاء العقل والتمييز، وهو أكمل الأحوال، إذ يجمع بين شهود الحق وخدمة الخلق. -
المجذوب وصفاته
المجذوب عند الصوفية هو من جذبه الله إليه حتى صار قلبه مشغولاً بالحق، معرضاً عن الدنيا. ومن صفاته كما وصفها ابن عجيبة في إيقاظ الهمم:
- أنه مستغرق في مشاهدة الحق، غائب عن الالتفات إلى الخلق.
- قد تظهر عليه حالات غير مألوفة للعامة كالصمت الطويل أو الغيبة الفكرية.
- لا يملك اختيارًا لنفسه، لأنه مستسلم للعناية الإلهية.
غير أن ابن عجيبة ميّز بين المجذوب الصرف الذي لا يملك عقله، والمجذوب السالك الذي جمع بين الجذب والتمييز، وقال:
“الناس ثلاثة: سالك بلا جذب، ومجذوب بلا سلوك، ومجذوب سالك؛ والأكمل من جمع الله له بين الحالين.”
- أنه مستغرق في مشاهدة الحق، غائب عن الالتفات إلى الخلق.
-
الجذب والولاية عند الصوفية
يرى الصوفية أن الجذب من علامات الولاية، لأن الولي هو من اجتباه الله وقربه. لكنهم يفرّقون بين المجذوب الذي يُغلب عليه الحال حتى يخرج عن حدود التكليف، وبين الوليّ الكامل الذي يظلّ على التزامه بالشريعة مع تمتّعه بالجذب.
قال الجنيد: “كل طريقٍ إلى الله مسدود إلا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ”.
فالجذب الصادق لا يتنافى مع الشريعة، بل هو ثمرة من ثمارها، إذ لا وصول بلا التزام، ولا ولاية بلا عبودية. -
مواقف العلماء من مفهوم الجذب
لم يخلُ مصطلح الجذب من الجدل بين علماء الشريعة والمتصوفة:
1. الموقف المؤيد:
رأى كثير من أئمة التصوف كالقشيري والسكندري وابن عجيبة أن الجذب حقيقة ربانية، ولا تعني سقوط التكليف، بل هي ترقٍّ في مقام الإيمان والمعرفة.2. الموقف الناقد:
أما بعض العلماء كابن خلدون، فقد انتقد المفهوم حين يتجاوز حدوده الشرعية، وقال في شفاء السائل:“المجذوب إذا فقد عقل التكليف سقط عنه الحدّ، فلا يُعدّ من الأولياء، لأن الولاية تقتضي الوعي والمسؤولية.”
وهذا التفريق ضروري بين الجذب الشرعي الذي يقود إلى القرب، والجذب البدعي الذي يفضي إلى الانحراف أو التواكل.
-
الجذب في ضوء القرآن والسنة
يرى الصوفية أن أصل الجذب مستند إلى نصوص شرعية، منها قوله تعالى:
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30].
فالعودة إلى الفطرة هي نوع من الجذب إلى أصل النور الإلهي.وكذلك قوله تعالى:
{اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ} [الشورى: 13]،
يُفهم منه أن الاجتباء نوع من الجذب، لأن الله يجذب عبده إليه بالهداية والمحبة.أما في السنة، فقد ورد في الحديث القدسي:
«وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...» (رواه البخاري).
وهذا الحبّ الإلهي هو صورة من صور الجذب التي ترفع العبد إلى مقام القرب. -
البعد الفلسفي لمفهوم الجذب
من منظور فلسفي، يعكس الجذب العلاقة بين الفاعل الإلهي والمفعول البشري. فالعبد لا يتحرك نحو الله إلا إذا جذبه الله إليه أولًا، كما في قوله تعالى:
{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: 21].
فالفعل الإلهي هو الأصل، والسلوك البشري تابع له. وهذا المفهوم يجعل الجذب تعبيرًا عن الفعل الأحادي لله في قلب العبد، بما يعكس مركزية الإرادة الإلهية في التصور الصوفي للوجود. -
الجذب في التجربة الصوفية المعاصرة
في التصوف المعاصر، بقي مفهوم الجذب حاضرًا بوصفه تجربة روحية داخلية، لكنها تُفسَّر اليوم تفسيرًا أكثر اعتدالاً. فالكثير من المتصوفة المعاصرين يرون أن الجذب هو حالة وعي روحيّ عميق، يُدرك فيها العبد معاني القرب والمحبة، دون أن ينعزل عن المجتمع أو يسقط عنه التكليف.
كما أصبح الجذب عندهم رمزًا للتحول الإيجابي في الشخصية، لا للخروج عن دائرة العمل والعبادة. -
الجذب بين الإلهام والجنون
من القضايا المثيرة التي ناقشها العلماء هي تمييز المجذوب الحقيقي عن “المتجذّب” المدّعي أو المصاب بحالة عقلية.
فالمجذوب الصادق – كما بيّن القشيري – “لا يتكلم بما يخالف الشريعة، ولا يدّعي مقامًا لم يُؤذن له فيه”، بينما المزيّف “يخالف ظاهر الدين ويتذرّع بالجذب لتبرير أفعاله”.
لذلك نصّ العلماء على ضرورة التمييز بين حال الولاية وحال الغفلة، وأن الجذب لا يُقاس بالاضطراب العقلي أو التصرّف الشاذ. -
الخاتمة
يُعدّ مصطلح الجذب عند الصوفية من أعمق المفاهيم التي عبّرت عن تجربة العبد في التقرّب من الله بعنايةٍ ربانيةٍ خاصّة. فهو ليس انفعالاً نفسياً عارضاً، بل مقامٌ من مقامات العارفين، تتجلّى فيه محبة الله لعبده واصطفاؤه له.
غير أن الصوفية أنفسهم شدّدوا على أن الجذب لا يعني سقوط الفرائض ولا تعطيل الشريعة، بل هو ثمرة للطاعة والصدق في السلوك.
ومن ثم فإن الفهم الصحيح للجذب يقتضي الجمع بين العقل والشريعة والحال، لأن العرفان الصادق لا يكون إلا على قاعدة العلم والعمل.
وبذلك يبقى الجذب رمزًا للفيض الإلهي الذي يُقْرِبُ الأرواح إلى بارئها، ويكشف عن بعدٍ عميق في التجربة الدينية الإسلامية، يزاوج بين العبودية والمحبة، والسلوك والعناية، والمجاهدة والاصطفاء.