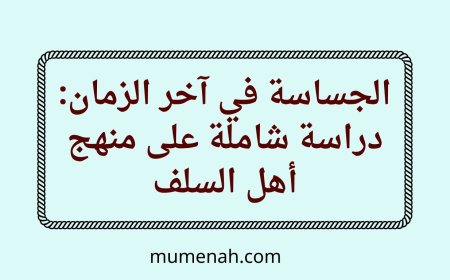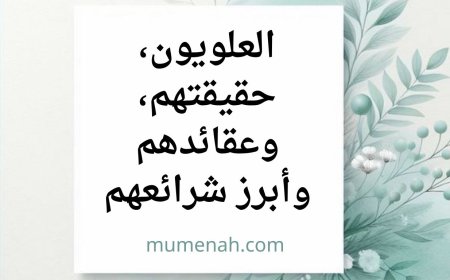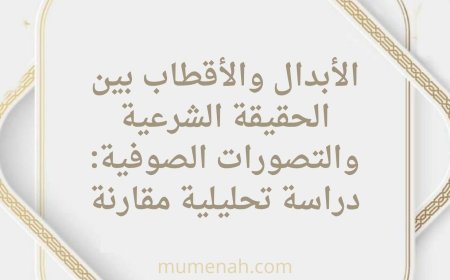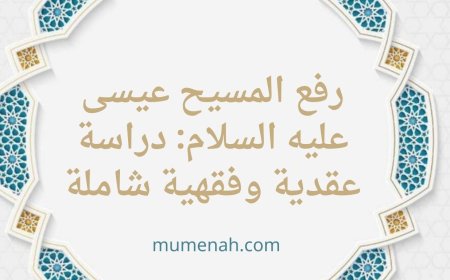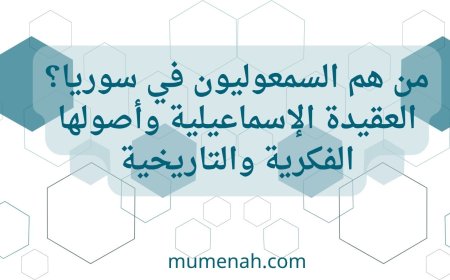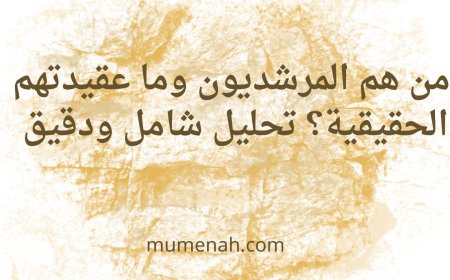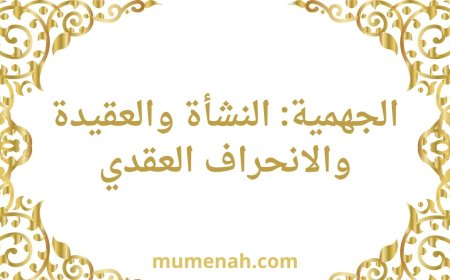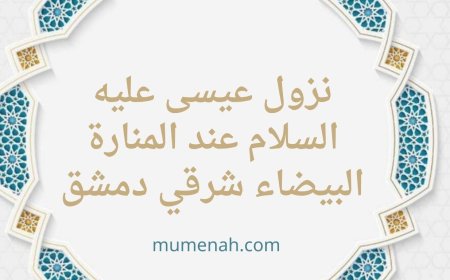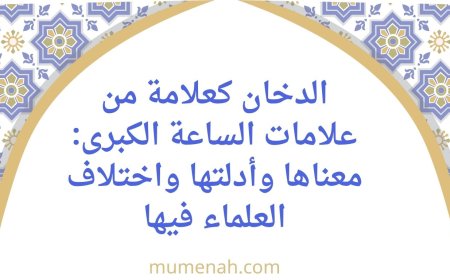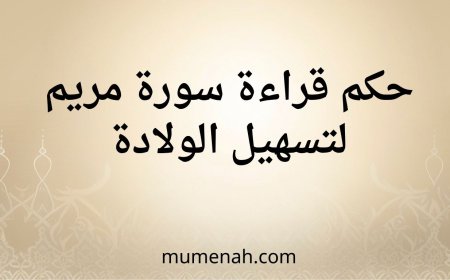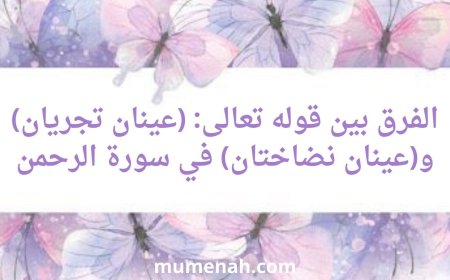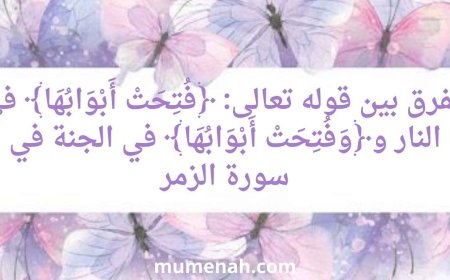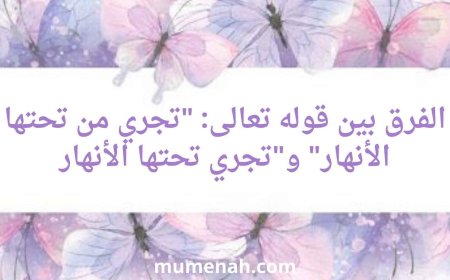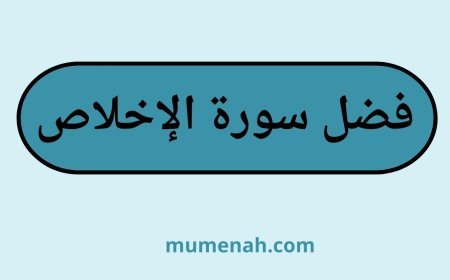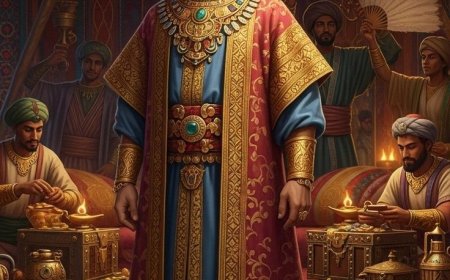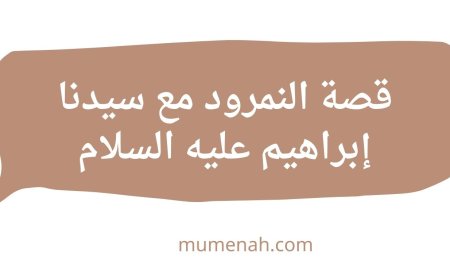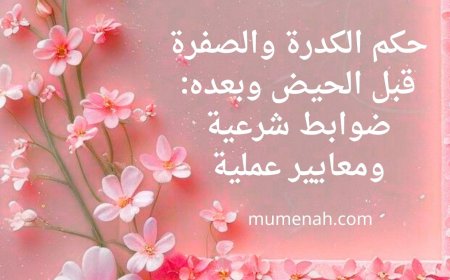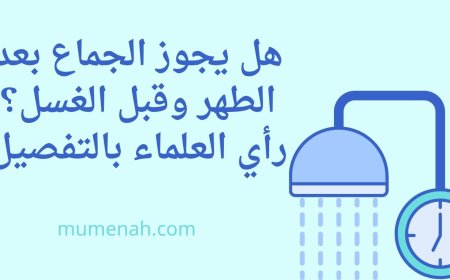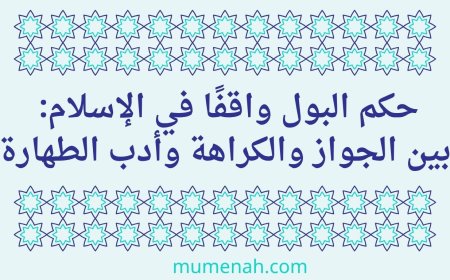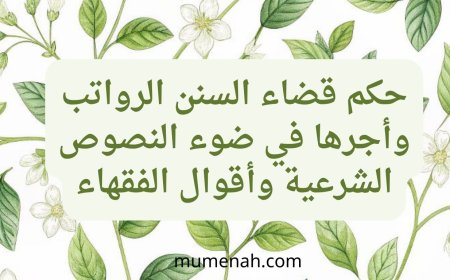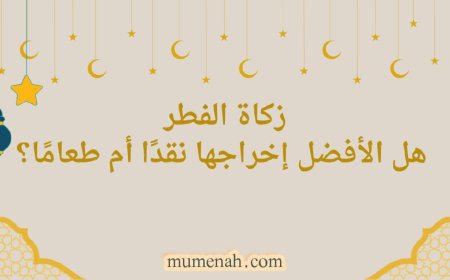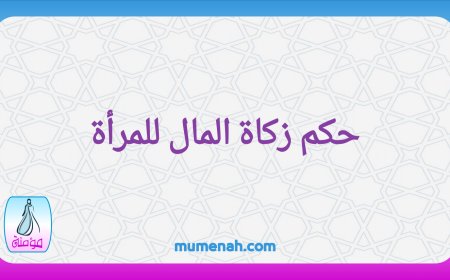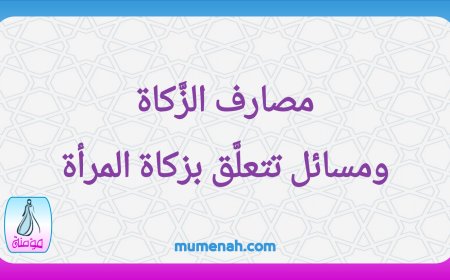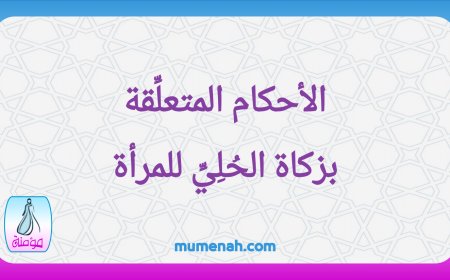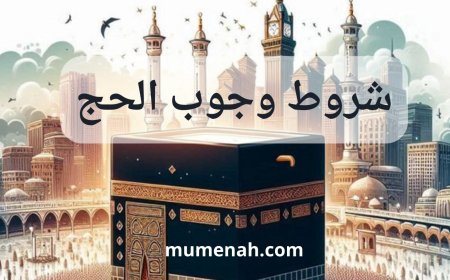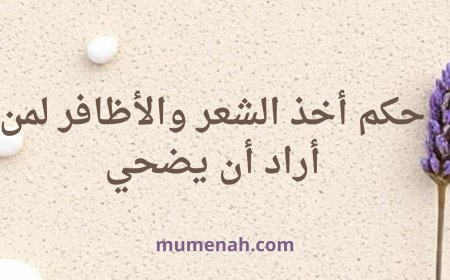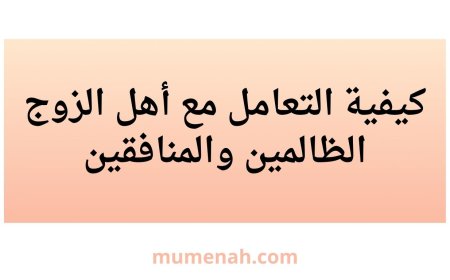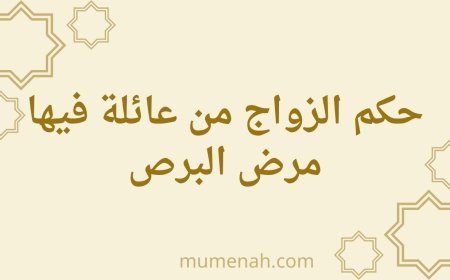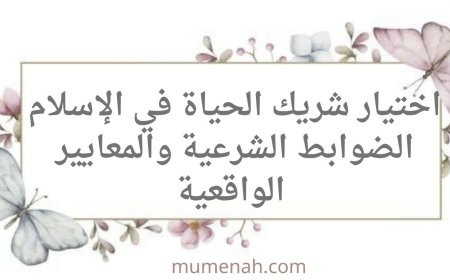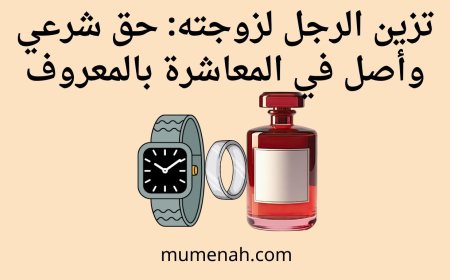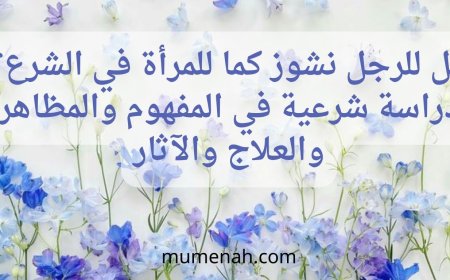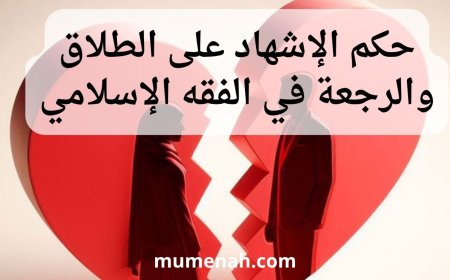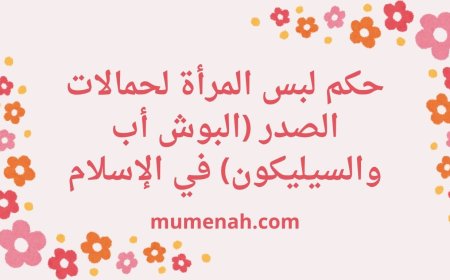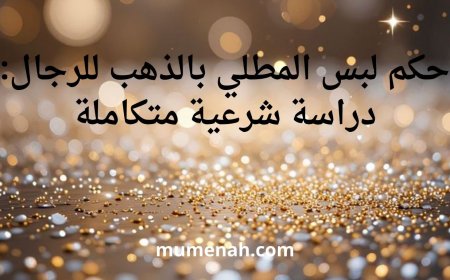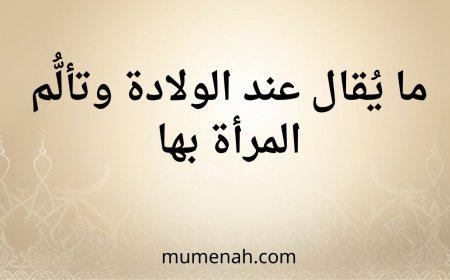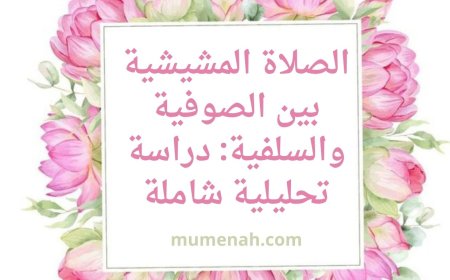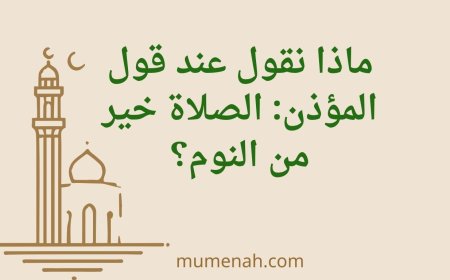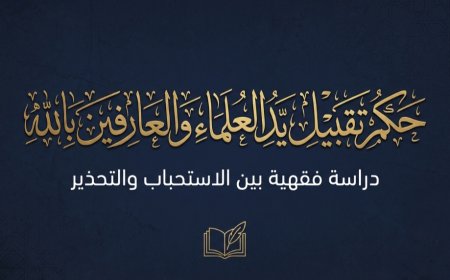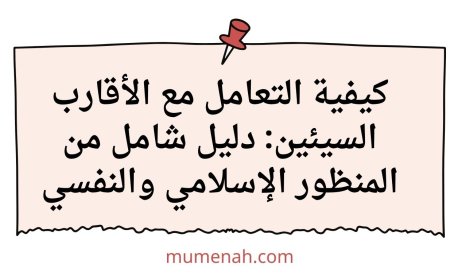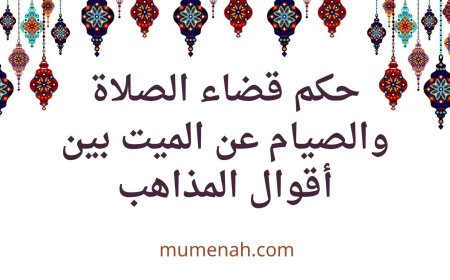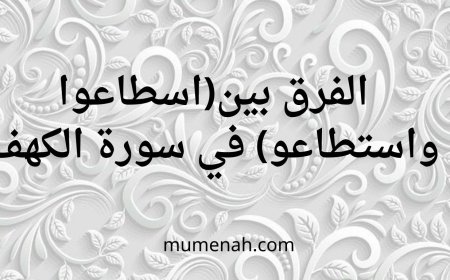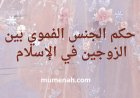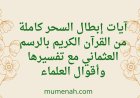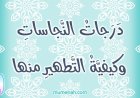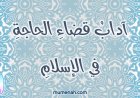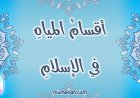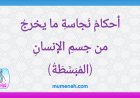الفرق بين (تستطع و تسطع) في سورة الكهف
تعرف على الفرق الدقيق بين قوله تعالى: (ما لم تستطع عليه صبرا) و(ما لم تسطع عليه صبرا) في سورة الكهف، مع تفسير ابن كثير وآراء علماء اللغة، وبيان الحكمة البلاغية واللغوية وراء هذا الاختلاف المعجز في القرآن الكريم.
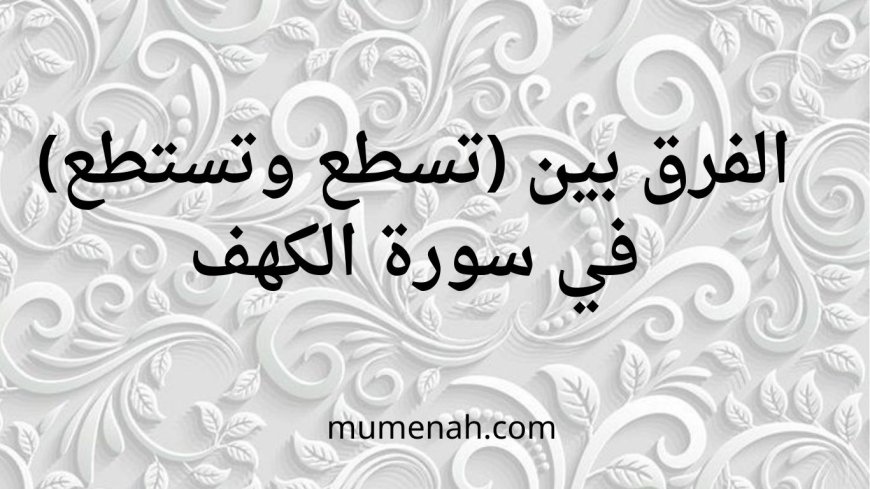
-
مقدمة
تُعدُّ سورة الكهف من السور العظيمة التي تحمل بين آياتها الكثير من الحكم والدروس، ومن أبرزها قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، التي جسدت عظمة العلم الإلهي، وحدود العقل البشري أمام حكمة الله تعالى. ومن المواضع الملفتة في هذه القصة قول الله تعالى:
- ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف:78]
- ﴿ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف:82]
وهنا يبرز سؤال جوهري: ما الفرق بين (تستطع) و(تسطع)؟ ولماذا عبّر القرآن في الموضع الأول بـ تستطع، وفي الثاني بـ تسطع؟
- ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف:78]
-
الزيادة في المبنى زيادة في المعنى
يقرر علماء اللغة قاعدة أساسية: "الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى". وهذا ما ينطبق على الفارق بين (تستطع) و(تسطع).
- كلمة تستطع: أطول من حيث المبنى، ما يوحي بالثقل والصعوبة.
- كلمة تسطع: أخف من حيث اللفظ، وهو ما يتناسب مع خفة الأمر بعد أن زال الإشكال وانكشف المعنى.
فالقرآن الكريم استخدم الكلمة الأطول في الموضع الذي كان موسى فيه في أشد الحيرة، قبل أن يعرف تأويل أفعال الخضر. ثم استخدم الكلمة الأخف بعد أن فُسرت له الأمور، فأصبح الصبر ممكناً والفهم أوضح.
- كلمة تستطع: أطول من حيث المبنى، ما يوحي بالثقل والصعوبة.
-
تفسير ابن كثير
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره:
"ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: ﴿تسطع﴾، وقبل ذلك كان الإشكال قويًا ثقيلاً، فقال: ﴿سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا﴾، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف."
ويضرب ابن كثير مثالاً آخر من القرآن الكريم يوضح هذه الدقة في اختيار الألفاظ، وهو قوله تعالى في شأن يأجوج ومأجوج:
- ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف:97] أي لم يقدروا على الصعود فوق السد، وهو أمر صعب.
- ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف:97] أي لم يقدروا على نقبه، وهو أشق من مجرد الصعود، فناسب أن يأتي باللفظ الأطول "استطاعوا".
- ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف:97] أي لم يقدروا على الصعود فوق السد، وهو أمر صعب.
-
وجه بلاغي عميق
هذا الفارق اللفظي يعكس وجهاً من أوجه البلاغة القرآنية، حيث يتم التعبير عن المعنى بما يتناسب مع المقام:
- قبل التفسير: موسى عليه السلام كان يواجه أفعالاً ظاهرها غريب (خرق السفينة، قتل الغلام، إقامة الجدار) دون أن يعرف الحكمة منها، فجاء التعبير بـ تستطع الثقيلة، لأن الأمر كان ثقيلاً على نفسه.
- بعد التفسير: لما بيّن الخضر الحكمة، زال العجب وانكشف الإشكال، فجاء التعبير بـ تسطع الأخف، لأن موسى أصبح في موقف أسهل في تقبّل الأحداث بعد فهم حكمتها.
- قبل التفسير: موسى عليه السلام كان يواجه أفعالاً ظاهرها غريب (خرق السفينة، قتل الغلام، إقامة الجدار) دون أن يعرف الحكمة منها، فجاء التعبير بـ تستطع الثقيلة، لأن الأمر كان ثقيلاً على نفسه.
-
رأي علماء اللغة
أشار علماء اللغة أيضاً إلى أن (تستطع) و(تسطع) لغتان صحيحتان في العربية، وقد وردتا في القرآن الكريم. لكنهم رجّحوا أن:
- تستطع أفصح وأكثر استعمالاً.
- تسطع أقل شهرة لكنها مستعملة أيضاً، وجاءت هنا ببلاغة خاصة تتناسب مع خفة الموقف بعد البيان.
- تستطع أفصح وأكثر استعمالاً.
-
حكمة الانتقال من (تستطع) إلى (تسطع)
من الناحية المعنوية، يمكن القول إن الانتقال من (تستطع) إلى (تسطع) يعكس رحلة موسى عليه السلام:
1. مرحلة الغموض والصعوبة: حيث كان يواجه ما لم يفهم حكمته، فجاء التعبير الأثقل (تستطع).
2. مرحلة البيان والوضوح: حيث انكشف له وجه الحكمة في أفعال الخضر، فجاء التعبير الأخف (تسطع).
وهذا يعلّمنا أن الصعوبة قد تخف مع العلم والفهم، وأن ما يبدو ثقيلاً على النفس في البداية، قد يصبح مقبولاً بعد إدراك الحكمة.
-
الخلاصة
إن الفرق بين قوله تعالى:
- ﴿ما لم تستطع عليه صبرا﴾
- ﴿ما لم تسطع عليه صبرا﴾
هو أن الأولى جاءت في مقام الشدة والغموض، حيث لم يكن موسى يعرف الحكمة من أفعال الخضر، فجاء التعبير بالأثقل. أما الثانية فجاءت بعد أن فُسرت الأمور وتبينت الحكمة، فجاء التعبير بالأخف.
وهذا من إعجاز القرآن الكريم، حيث تتجلى البلاغة في اختيار الألفاظ بما يتناسب مع المعنى والسياق.
- ﴿ما لم تستطع عليه صبرا﴾