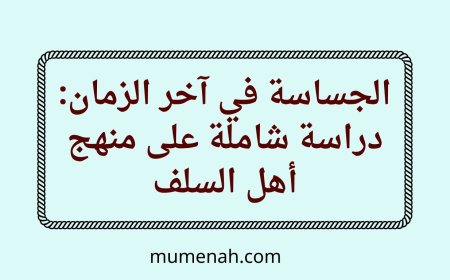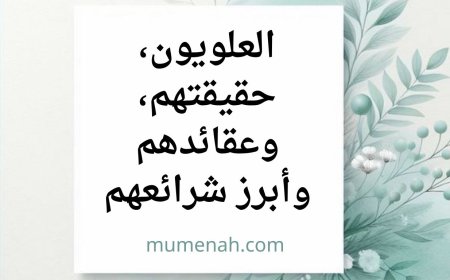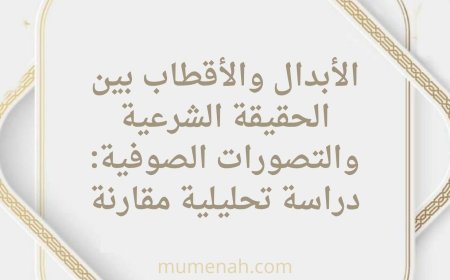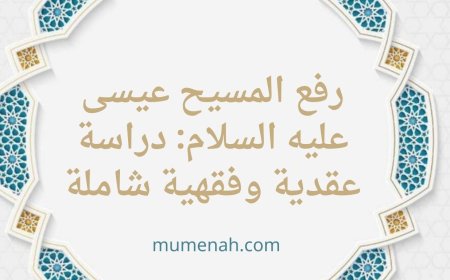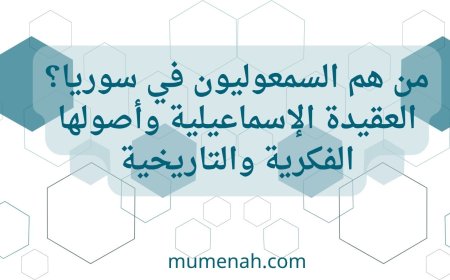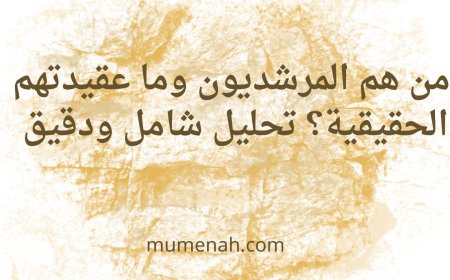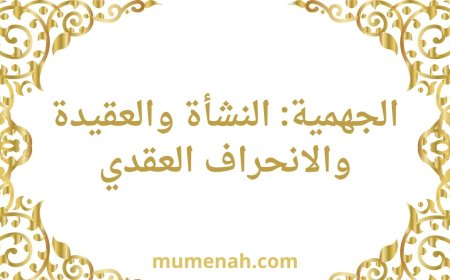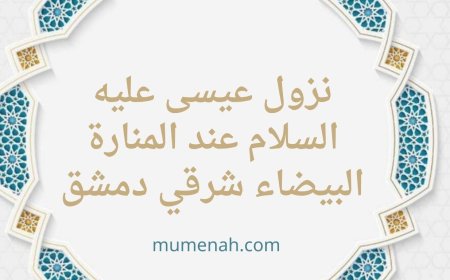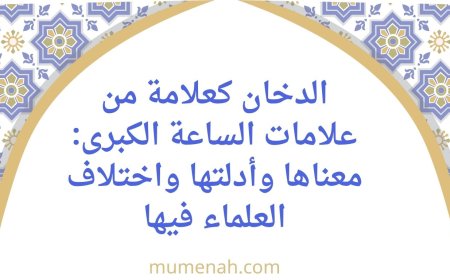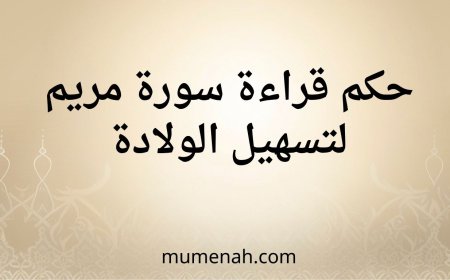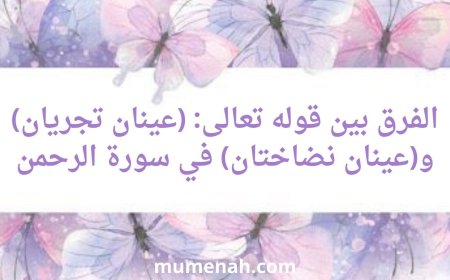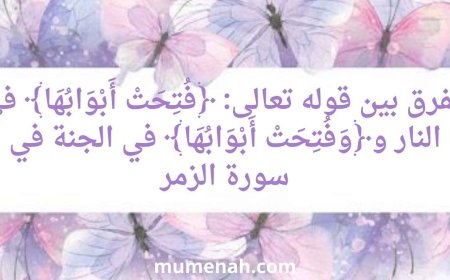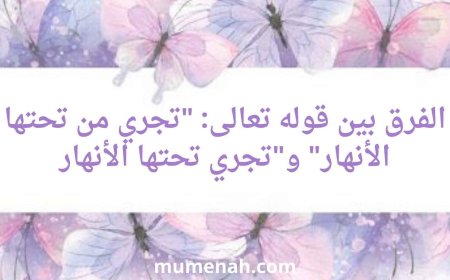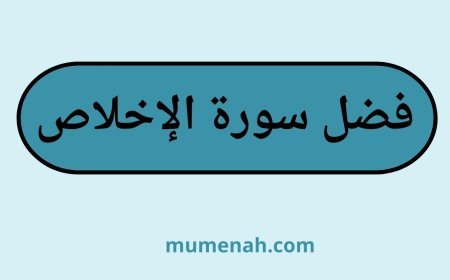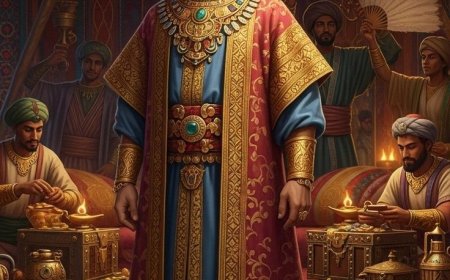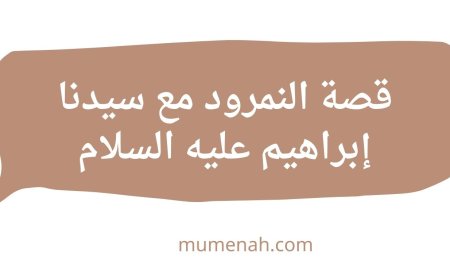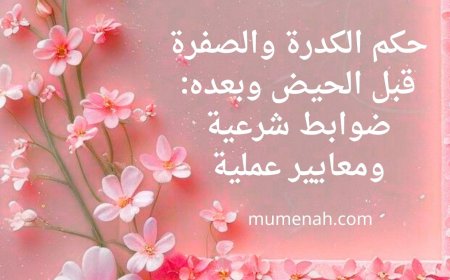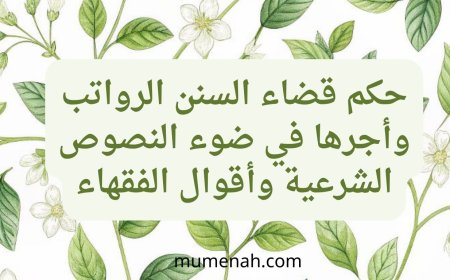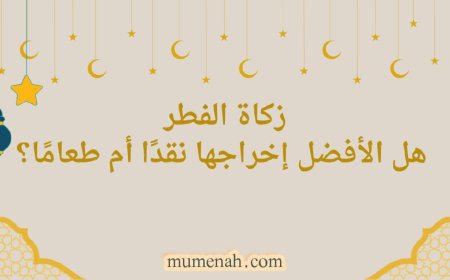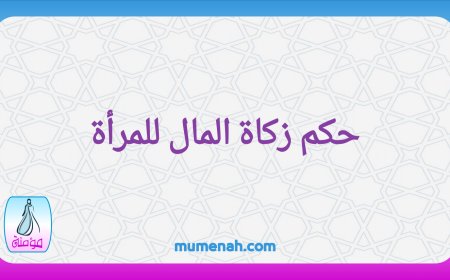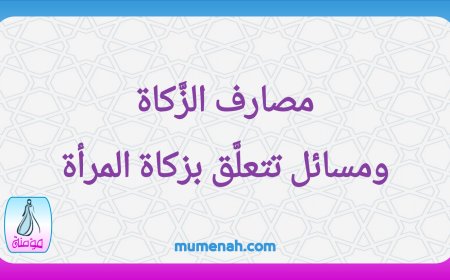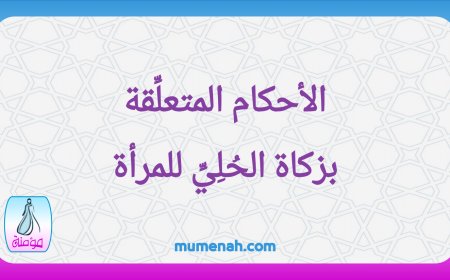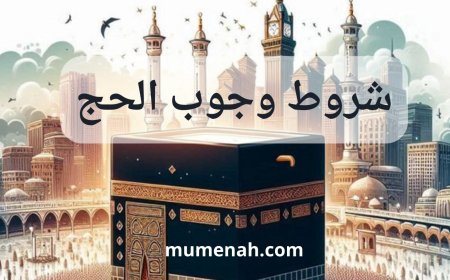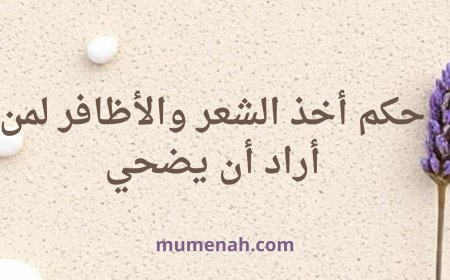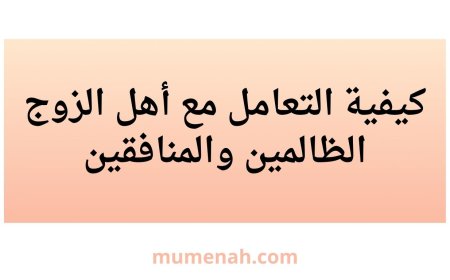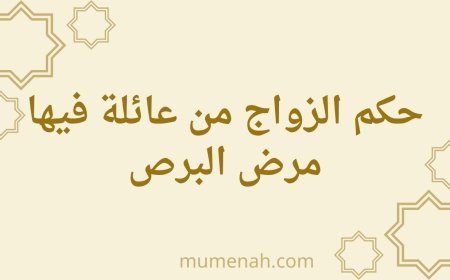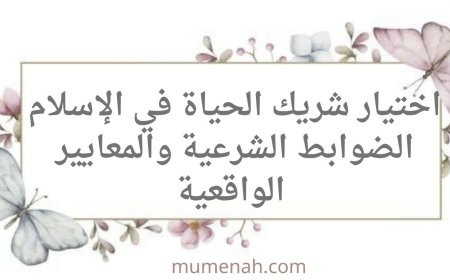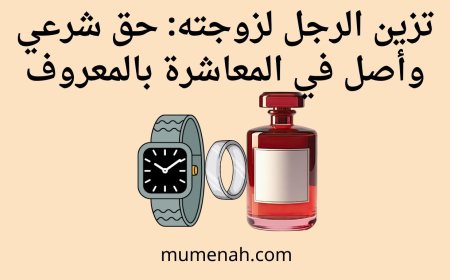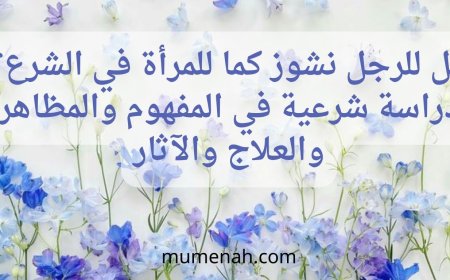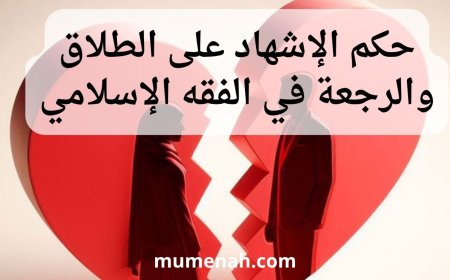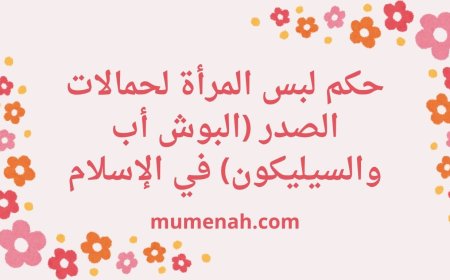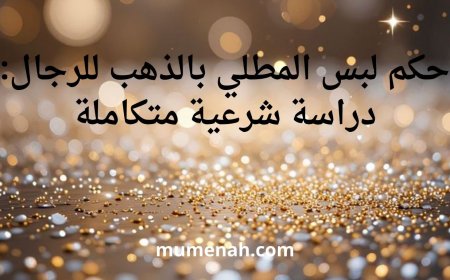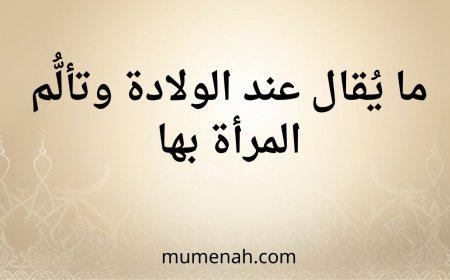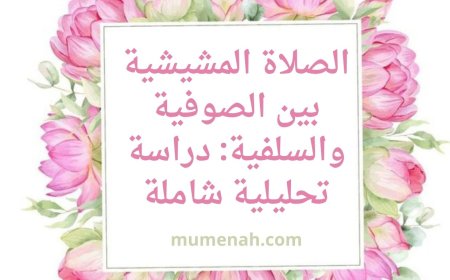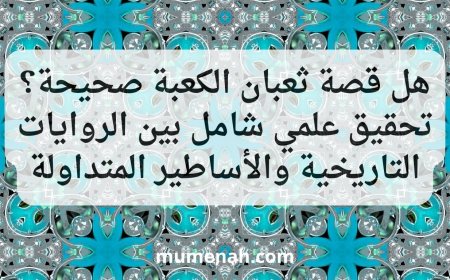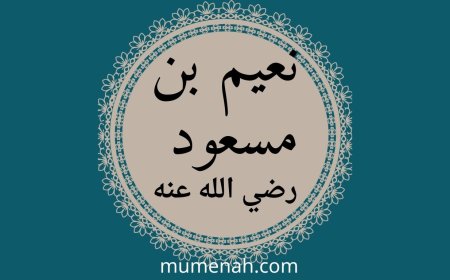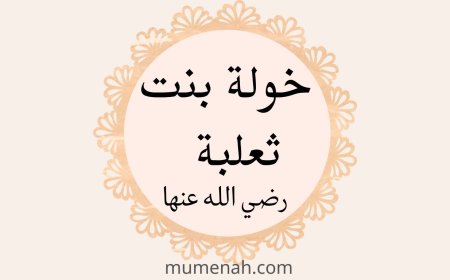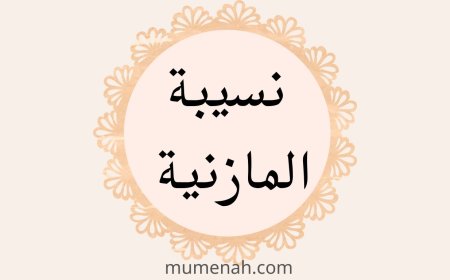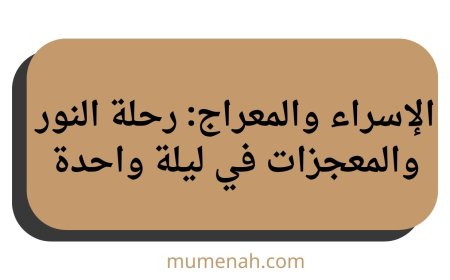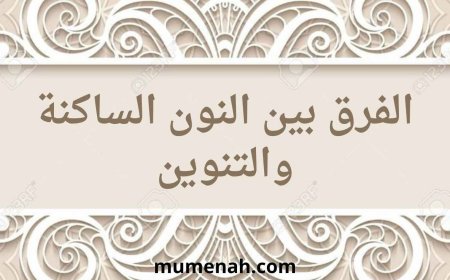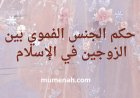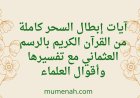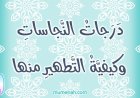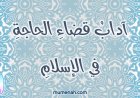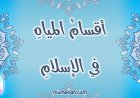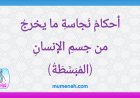السكتات في القرآن الكريم: مواضعها وأحكامها عند حفص عن عاصم
تعرف على مواضع السكتات في القرآن الكريم وأحكامها عند القارئ حفص عن عاصم، مع بيان الحكمة من السكت وأدلته، وذكر السكتات الواجبة والجائزة، ودورها في تجويد المعنى القرآني وفهمه، في مقالة شاملة ومفصلة.

-
مقدمة
يُعدّ علم التجويد من العلوم العظيمة التي عني بها العلماء لحفظ كتاب الله عز وجل من التحريف، ومن ضمن قواعده الدقيقة "السكتات القرآنية"، وهي لحظات يُقطع فيها القارئ صوته دون تنفس، لتحقيق غرض بياني أو لغوي، أو اتساق المعنى. وتعد رواية حفص عن عاصم من الروايات التي اشتهرت بالسكتات المحددة في بعض المواضع، والتي يجب على القارئ معرفتها وتطبيقها.
-
تعريف السكت لغة واصطلاحًا

السكتات الواجبة والسكتات الجائزة عند حفص - السكت لغةً: القطع والإخفاء.
- اصطلاحًا: قطع الصوت زمنًا يسيرًا دون تنفس، ويكون هذا الزمن أقل من زمن الوقف.
قال ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" (1/240):
"السكت: هو قطع الصوت زمنًا يسيرًا من غير تنفس، وهو دون الوقف عادة."
- السكت لغةً: القطع والإخفاء.
-
مواضع السكتات الواجبة لحفص عن عاصم
انفرد القارئ حفص عن عاصم بأربعة مواضع يجب فيها السكت، دون تنفس، وهي كما يلي:
1. السكت على ألف: (عِوَجًا)
- الموضع: قوله تعالى:
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا * قَيِّمًا...} [الكهف: 1-2]. - الحكمة: السكت يمنع توهم أن كلمة "قيّمًا" صفة لـ"عوجًا"، وهذا خطأ في المعنى؛ إذ لا يصح وصف المعوج بالقيم.
- التجويد: يُسكت على "عِوَجًا" سكتة خفيفة دون تنفس، ثم يُستأنف "قَيِّمًا".
2. السكت على ألف: (مَرْقَدِنَا)
- الموضع: قوله تعالى:
{قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ...} [يس: 52]. - الحكمة: حتى لا يُفهم أن "هذا ما وعد الرحمن" هو من كلام الكفار، بينما هو من كلام الله أو الملائكة.
- الأداء: يُسكت على "مرقدنا" قبل استئناف "هذا" سكتة لطيفة دون تنفس.
3. السكت على نون: (مَنْ رَاقٍ)
- الموضع: قوله تعالى:
{وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ} [القيامة: 27]. - الحكمة: لئلا يُظن أن "من راق" كلمة واحدة، بينما هما كلمتان منفصلتان: "من" استفهامية، و"راقٍ" فاعل يرقي.
- التجويد: يُسكت سكتًا يسيرًا على "من" ثم يُستأنف "راقٍ".
4. السكت على لام: (بَلْ رَانَ)
- الموضع: قوله تعالى:
{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم...} [المطففين: 14]. - الحكمة: السكت يبين انفصال "بل" عن "ران"، وإلا فتوهم أنها كلمة واحدة لا يؤدي المعنى المراد.
- المعنى: "ران" أي غطى وغطّم الذنوب قلوبهم حتى حجبتها عن الحق.
- الأداء: يُسكت سكتة يسيرة على "بل" ثم يُتبع بـ"ران".
وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذه المواضع بقوله:
وسكتة حفص دون قطع لطيفة
على ألف التنوين في عوجًا بلا
وفي نون من راق ومرقدنا ولا
م بل ران والباقون لا سكت موصلا - الموضع: قوله تعالى:
-
السكتات الجائزة عند حفص
بالإضافة إلى المواضع الأربعة الواجبة، هناك موضعان يجوز فيهما السكت، وهي:
1. السكت بين سورتي الأنفال والتوبة
- لأن سورة التوبة تبدأ بدون بسملة، فقد ورد الأداء بالسكت اليسير عند وصل السورتين، ليُفصل بينهما معنويًا.
2. السكت على هاء (مَالِيَهْ) في قوله: (مَالِيَهْ. هَلَكَ)
- الموضع: قوله تعالى:
{مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة: 28-29]. - الحكمة: الفصل بالسكت يظهر الوقف على "مالِيَهْ"، و"سلطانِيَهْ"، ثم يُستأنف "هلك" و"عنّي" بعده، وهو الأقوى في الأداء.
- الأداء: يُسكت على الهاء سكتة خفيفة قبل استئناف "هلك عني".
- لأن سورة التوبة تبدأ بدون بسملة، فقد ورد الأداء بالسكت اليسير عند وصل السورتين، ليُفصل بينهما معنويًا.
-
خلاف القرّاء في السكت لحفص
أوضح العلماء أن السكتات عند حفص وردت بطريق الأشناني عنه، أما من طريق الفيل وعمرو فليس فيها سكت.
وقد جاء في "إتحاف فضلاء البشر" ما يلي:
"وبكل من السكت والإدراج قرأت من طريق الأشناني"،
أي أن بعض الطرق رواها بالسكت وبعضها بالإدراج (الوصل دون سكت)، وكلها صحيحة بالتلقي والمشافهة.كما أن السكت عند حفص لا يكون إلا مع مد المنفصل، لأن من روى له السكت (الأشناني) لا يروي إلا بالمد، أما من يروي بالقصر فلا سكت عنده.
-
أهمية التلقي في ضبط السكت
رغم توثيق هذه المواضع في الكتب، يبقى الأصل في السكتات القرآنية هو التلقي والمشافهة عن الشيوخ، كما هو دأب أهل الإسناد في علوم القراءات، وقد نص العلماء على ذلك:
"وإنما طريقة ضبط ذلك في العمل والأداء: ما يتلقاه القارئ عن شيوخه، ويشافههم به."
-
خاتمة
إن السكتات في القرآن الكريم تمثل دقة اللغة العربية وجمال الترتيل القرآني، وقد اعتنى بها القراء لتوصيل المعنى بدقة، والابتعاد عن اللبس أو الخطأ في المعنى. وتعلّم هذه السكتات وتطبيقها بدقة يعد من تمام إحسان تلاوة القرآن الكريم، وهي سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراء الصحابة من بعده.
-
مصادر ومراجع
- "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري
- "القول السديد في علم التجويد" لعلي أبو الوفا
- "غاية المريد في علم التجويد"
- "إتحاف فضلاء البشر"
- "شرح طيبة النشر" للنويري
- "الوافي شرح الشاطبية"
- "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري